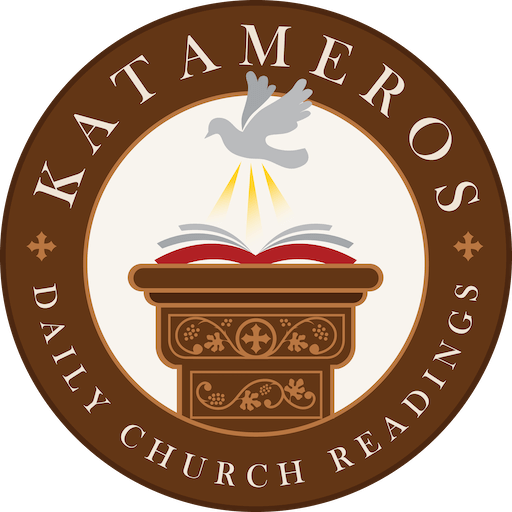“وَمَتَى ظَهَرَ رَئِيسُ الرُّعَاةِ تَنَالُونَ إِكْلِيلَ الْمَجْـدِ الَّذِي لاَ يَبْلَى.” (١بط ٥: ٤)
[كراع صالح سعيت في طلب الضال، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض] (القدّاس الغـريغـوري)
[حتى الآن المسيح الملاصق لنا الـذي أعـد المائدة هـو بنفسه يقدسها فإنه ليس إنسان يحـول القـرابين إلى جسد المسيح ودمه بل المسيح نفسه الذي صلب عنا ينطق الكاهن بالكلمات لكن التقـديس يتـم بقـوة الله ونعمته بالكلمة التي نطـق بهـا (هـذا هـو جسـدي) تتقـدس القرابيـن] (القديس يوحنا ذهبي الفم)[1]
شـواهــد القــراءات
(تث١١: ٢٩)- الخ، (ص١٢: ١- ٢٧)، (١مل١٧: ٢)- الخ)، (أم٥: ١- ١٢)، (إش٤٣: ١- ٩)، (أي٣٠: ٩)- الخ، (ص٣١: ١)، (ص٣٢: ١- ٥)، (مز٨٥: ٨، ٩)، (مر١٢: ٢٨- ٣٤)، (عب١٢: ٥- ١٦)، (١بط ٤: ١٥)- الخ، (ص٥: ١- ٥)، (أع١٥: ٣٦)- الخ، (ص١٦: ١- ٣)، (مز١٣٧: ١) (يو٨: ٢١- ٢٧).
شــرح القـــراءات
تتكلّم قـراءات اليـوم عن رئيس الـرعاة فهو منذ البدء يرعي شعبه في القديم ويدبّر الكنيسة بوصاياه وعطاياه وتأديباته المملوءة حباً خلال حضوره الـدائم وسط شعبه.
يبدأ سفر التثنية برعايـة الله لشعبه في القـديـم وميراثهم لأراضي الأمـم وسكناهـم فيها.
“لأنكم عابرون الأردن لتدخلوا وتملكوا الأرض التي أعطاكم الـرب إلهكم ميراثاً كل الأيام لتمتلكوها وتسكنون فيها، وتأكلون هناك أمام الـرب إلهكم وتفرحون بجميع ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الـرب إلهكم”.
وفي سفر الملوك يعول الله إيليا النبي سواء عن طريق الغربان أو عن طريق إمرأة بسيطة ويباركها بسببه.
“فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك، هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك، لأنه هكذا قال الـرب إله اسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وقسط الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي الـرب مطراً على وجه الأرض”.
وفي سفر الأمثال يحذّر الله من الخطيّة التي تجعل الإنسان يخسر رعاية وبركة الله في كل ما له.
“أبعد طريقك عنها ولا تَدنُ من أبـواب بيتها لئلا تدفع حياتك للآخرين ومالك لغير الـرحماء لئلا يشبع الغرباء من قوتك وأتعابك لا تعطيها للآخرين”.
وفي سفـر أشعياء يعلـن الله وعوده العظيمة لرعاية أولاده ويعلن هدف خلقتهم أن يعطيهم مجده.
“لا تخف فإني قد افتديتك ودعوتك بإسمك، أنت لي إذا اجتزت في المياه فإني معك وفي الأنهار فلا تغمرك، وإذا سلكت في النار فلا تحترق ولا يلفحك اللهيب، لا تخف فإني معك وسآتي بنسلك من المشرق وأجمعك من المغرب، أقـول للشمال هات وللجنوب لا تمنع، كل من يدعي بإسمي فإن لمجدي خلقته وجبلته وصنعته، من منهم يخبركم بهذا ويعلمكم بالأوائل”.
وفي سفر أيوب يتعاتب أيوب مع الله وكيف كان في غناه يهتمّ بكل الناس ويستخدم تعبير: إن كنت عشرة مرّات باحثاً عن سبب لتجربته المؤلمة رغم رعايته ورحمته بكل المحتاجين.
“إن كنت رفضت حـق عبدي وأمتي في دعـواهما علىَّ، إن كنت أكلت خُبـزي وحدي ولم يأكـل منه اليتيـم، إن كنت رأيت هالكاً من العـري ولم أكسه، وإن كنت رفعت يـدي على اليتيم لما كان لي كل العون فلتسقط عضدي من كتفي ولتنكسر ذراعي من قصبتها”.
وفي مزمور باكـر عن عجائب وعظائم الله في الأمم والتي تجعل الشعوب تأتي إليه ساجدة معترفة بإسمه العظيم.
“كل الأمم الذي خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجـدون إسمك لأنك أنت عظيم وصانع العجائب”.
وفي إنجيل باكر يمدح الله الكاتب الذي كشف عن عظم محبّة الله والقـريب أفضل من المحرقات والذبائح، فرئيس الرعاة لا يحتاج لتقدماتنا كأنّنا نرعى إحتياجات بيته وهيكله بل يريد أولاً أن يأتي كل شئ من خلال الحب.
“فقال له الكاتب حسناً يا معلم بالحق قلت إن الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل فهمك، ومحبة قريبك أعظم من جميع المحرقات والذبائح، فلما رآه يسوع قد أجاب بعقل قال له : لستَ بعيداً من ملكوت الله”.
وفي البولس يوضّح إحدى أساسيات وعلامات رعاية الله لنا التأديبات الأبوية لأجل خلاصنا، وكأنّه يرد على تساؤلات أيـوب أن التجارب لا تعني غضب إلهي بل تعني تأديب الحب.
“يا بنيَّ لا تحتقر تأديب الـرب ولا تخر إذا وبخك فإن الذي يحبه الـرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله فاصبروا على التأديب فإن الله إنما يخاطبكم كالبنين فأي ابن لا يؤدبه أبوه، فإن كان آباء أجسادنا يؤدبوننا، لأيام حياتنا القليلة وعلى هواهم أما هـو فلمنفعتنا بالأكثر حتى ننال من قـداسته”.
وفي الكاثوليكون يعلـن نموذج الـرعاية في الكنيسة المقـدّسة دون إضطرار بل بقلب سليم وبنشاط وبإتضاع ودون تسلّط على الآخريـن.
“فأطلب إلى الكهنة الذين فيكم أنا الكاهن معهم والشاهد لآلام المسيح والمشارك أيضاً للمجد العتيد أن يُستعلن أنْ إرعـوا رعية الله التي فيكم متعاهدين لها، لا عن اضطرار بل عن اختيار كمثل الله، ولا لـربح قبيح بل بقلب سليم، ولا كمن يتسلط على ميراث الله بل صائرين أمثلة للـرعية، ومتى ظهر رئيس الـرعاة تنالون إكليل المجـد الذي لا يبلى”.
وفي الإبركسيس أهميّة الإفتقاد ومتابعة المؤمنين كعلامة على عمق الـرعاية الكنيسة.
“وبعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الأخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الـرب كيف هـم”.
لكن أيضاً يبرز ضعفات الـرعاة مهما كانوا ومهما كان عمل النعمة فيهم وفي خدمتهم.
“فصارت بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر فأخذ برنابا مرقس وأقلع إلى قبرس واختار بولس سيلا وخـرج مستودعاً من الأخـوة إلى نعمة الله”.
وفي مزمور القـدّاس تسبّح النفس وتعترف لإلهها الذي يستجيب لصلواتها وتفـرح بتسبيحه قـدّام هيكله وأمام ملائكته.
“أعترف لك من كل قلبي لأنـك استمعت كل كلمـات فمي أمـام الملائكة أرتـل لـك وأسجد قدام هيكلك المقدس”.
وفي إنجيل القـدّاس يعلن ابن الله رعايته وإرساليته في العالم والتي كانت مُعْلَنة منذ البدء في معاملات الله مع شعبه في العهد القـديـم.
“قال لهم يسوع من البدء كلمتكم مراراً وعندي كثير أقوله من أجلكم وأحكم لكن الذي أرسلني هـو حـق”.
ملخّص القـــراءات
| سفـر التثنيـــة | أعطى الله لشعبه في العهد القـديـم ميراث الأمم. |
| سفـر الملــوك | يعول الله خدّامه خلال خليقته. |
| سفر أشعيـــاء | مجـد الله في الإنسان هـو هـدف خلقته ووعـود الله هى ضمان سلامته. |
| سفر أيـــــوب | يسمح الله بتأديبات الحب الإلهي لنا رغم رعايتنا ورحمتنا للآخرين. |
| مزمور باكــر والقــــــــدّاس | تسبٌح كل نفس وكل الشعوب الله في هيكله وأمام ملائكته على عجائبه. |
| إنجيل القـدّاس | محبّة الله والقـريب أعظم من كل الذبائح والتقدمات. |
| البـولـــــــــس | تأديبات الله إحدي أساسيات رعايته الأبوية لنا. |
| الكاثـوليكــون | الإتضاع وعدم التسلّط والقلب السليم وبغضة الربح القبيح علامات الرعاية في الكنيسة. |
| الإبركسيـــس | عمق الرعاية يظهر في إفتقاد المؤمنين وضعف الرعاة لا يمنع عمل الله معهم. |
| إنجيل القـدّاس | يعلن ابن الله عن رعايته منذ البدء خلال الآباء والأنبياء وإرساليته من الآب في ملء الزمان. |
الكنيسة في قــراءات اليــوم
| إنجيل باكــــــر | حفظ الوصيّة. |
| البولــــــــــــس | الجهاد الروحي. |
| الكاثوليكـــــون | الكهنوت والرعاية. |
| مزمور القدّاس | السجود قدّام الهيكل والتسبيح مع الملائكة. |
| إنجيل القـــدّاس | إرسالية الآب للإبن وأزلية ابن الله. |
أفكـار مقتـرحة للعظــات
(١) ماذا يقدّم الله في رعايته لنا
| Ã سفر أشعياء | ← | مجده الإلهي: لمجـدي خلقته. |
| Ã سفر أشعياء | ← | حمايته لأولاده: اذا اجتزت في المياه فإني معك. |
| Ã سفر الملوك | ← | تدبير الإحتياجات: أمرت الغربان أن تعولك. |
| Ã البـولــــــس | ← | تأديبات الحب: الـذي يحبه الـرب يؤدبه. |
(٢) ماذا يفعل الإنسان لكي يعيش ويدرك عمق رعاية الله
| Ã سفر أشعياء | ← | حفظ الوصيّة: فاحرصوا على جميع أوامره وأحكامه. |
| Ã سفر الأمثال | ← | التحفُّظ من الخطية: أبعد طريقك عنها. |
| Ã إنجيل باكـر | ← | التعمّق في محبة الله والقريب: تحب الرب إلهك من كل قلبك. |
| Ã البـولــــــس | ← | الجهاد الـروحي والإجتهاد: قـوموا الأيادي المسترخية. |
عظـات آبائيــة
العظة الآبائية الأولى : للقديس كيرلس الأسكندري
لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم – للقديس كيرلس الأسكندري[2]
وهو يشرح بأكثر دقة ما سوف يحدث، وإذ قد جعل كيفية الخلاص واضحة جداً فهو يبيَّن ثانية بأي طريق سوف يصعدون إلى حياة القديسين ويبلغون إلى المدينة التي هي فوق، أورشليم السماوية.
وهو لا يقول إن الإنسان ينبغي أن يؤمن بل يؤكد أن الإيمان يلزم أن يكون به هو. لأننا نتبرر بالإيمان به كإله من إله وكالمخلص والفادي وملك الكل والرب بالحق، لذلك يقول إنكم ستهلكون “إن لَم تؤمنوا أني أنا” أما الضمير “أنا” فيما يقول هو ذاك الذي كُتب عنه في الأنبياء: “استنيري، استنيري يا أورشليم لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك” (إش٦٠: ١). لأنه يقول: لأني أنا الذي منذ القديم أمرت أن تُنزع أمراض النَّفس عنها وأنا الذي وعدت بشفاء المحبة بالقول: “أرجعوا أرجعوا أيها البنون المرتدون” وأنا “سأشفي عصيانكم” (إر٣: ٢٢). “أنا هو الذي أعلنت أن الصلاح الإلهي القديم والصبر الذي لا يُجازي ينبغي أن يُسكب عليكم. ولذلك صرخت عالياً: “أنا أنا هو الماحي ذنوبك ولن أذكرها” (إش٤٣: ٢٥). ويقول: “أنا هو الذي قال لإشعياء النبي أغتسلوا، تنقوا، أعزلوا شرور قلوبكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشرور… وهلم نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت كالدودي (الأحمر) فإني أبيّضها كالصوف” (إش١: ١٦، ١٨). ويقول: أنا هو.. الذي عنه يقول إشعياء النبي نفسه: “يا صهيون التي تأتي بالبشارة السارة، اصعدي على جبلٍ عالٍ يا أورشليم التي تأتي بالبشارة السارة، ارفعي صوتك بقوة، ارفعي لا تخافي، هوذا إلهك. هوذا الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعمله أمامه… كراعٍ يرعي قطيعه، بذراعه يجمع الحملان ويريح المرضعات” (إش٤٠: ٩-١١).
ويقول أيضاً: “حينئذ ستنفتح عيون العمي وآذان الصُم سوف تسمع. حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس” (إش ٣٥: ٥-٦). ويقول: “يأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تُسرون به. هوذا يأتي قال رب الجنود، ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره، لأنه سيدخل مثل نار الممحص ومثل أشنان القصَّار” (ملا٣: ١-٢). ويقول: أنا هو الذي لأجل خلاص الناس وعدت بصوت المرنم أن أقدم نفسي ذبيحة لله الآب، وصرخت: “بذبيحة وقرباناً لم تُرد ولكن هيأت لي جسداً، بمحرقات وذبائح للخطيّة لم تُسر. ثم قلت ها أنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله” (مز٤٠: ٦- ٨). ويقول: أنا هو، والناموس بواسطة موسي كرز عني قائلاً هكذا: “يقيم لك الرب إلهك نبياً من بين أخوتك مثلي له تسمعون، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع” (تث١٨: ١٦-١٦).
لذلك يقول، سوف تهلكون وسوف توفون للديَّان العقاب العادل جداً بسبب كثرة شر أخلاقكم إذ لا تسمعون ذاك الذي سبق أن بشرّكم به قديسون كثيرون، وأيضاً بشهادة الأعمال التي أعملها أنا، لأنه بالتأكيد وحسب الحق، ليست هناك مجادلة تعفي أولئك الذين لا يؤمنون به من نوال العقاب، إذ نري أن الكتاب الموحي به من الله مملوء بالشهادات والأقوال عنه وهو نفسه يقدّم بأعماله مجداً مطابقاً لما تم التنبوء عنه منذ زمن بعيد.
(يو٨: ٢٤): ” فقلت لكم : إنكم تموتون في خطاياكم ” .
وبكلمات قليلة حول التصورات الرديئة لأولئك الذين فهموا هكذا وبعد أن وبخهم أيضاً بسبب كلامهم الغبي عنه، فإنه يرجع إلى هدفه الأصلي من حديثه ويلخصه مبيناً لهم الشر العظيم الذي سيكونون فيه وما الذي سوف يسقطون فيه، إن كانوا بعدم تعقل يرفضون أن يؤمنوا به، فهناك أمر ملائم جداً لأي معلّم حكيم ووقور، لأني أظن أن المعلم لا ينبغي أن يتصادم مع جهل سامعيه ولا أن يهمل في عنايته بهم، حتي إن لم يتعلموا الدروس بسهولة، ولكنه يعيد مرات كثيرة، ويرجع إلى نفس الأمور ويستعمل نفس الكلمات، (كما أن الحراث الذي يلازم الحقل ويبذل جهداً غير قليل فيه، فإنه حينما يكون قد زرع البذار في الأثلام، فإن رأي إحدى البذار تَلفْت، فإنه يعود ثانية إلى المحراث ولا يضن بأن يبذر على الأجزاء التي تَلفْت).
لأنه إذا لم يصل إلى هدفه في المرة الأولى فلن يحدث نفس الشيء في المرة الثانية. ومثل هذه العادة كان يمارسها بولس الإلهي عندما يقول في موضع ما: “كتابة هذه الأمور إليكم ليست عليَّ ثقيلة، وأمَّا لَكُمْ فهي مُؤمنة” (في٣: ١). هل ترى، كما أن المعلم يرتفع فوق الكسل، فبالنسبة للسامعين يكون الأمر عملاً مطمئناً؟ إذن فربنا يسوع المسيح يكرر حديثه بطريقة نافعة مع اليهود، ويؤكد أن عقوبة عدم الإيمان به لن تكون بأمور عابرة: لأنه يقول إن الذين لا يؤمنون فبالتأكيد سيموتون في خطاياهم. وأن الموت في التعدّيات هو حمل ثقيل لأنه سيسلم نفس الإنسان إلى اللهيب، الذي بلا شك، سوف يبيد الكل.
تموتون في خطيتكم – العلامة أوريجانوس[3]
- إنني أسأل إن كان يقول: “أنا أمضي وستطلبونني، وتموتون في خطيتكم” ليس لكل الحاضرين، وإنما للذين قد عرف أنهم لا يؤمنون به، ولذلك يموتون في خطيتهم، ويصيروا عاجزين عن أن يتبعوه. إنهم عاجزون لأنهم لا يريدون، فإنهم عاجزون، ولكنهم يريدون ما كان يليق بالقول: “تموتون في خطيتكم“
- يجيب أحد: إن كان قد نطق بهذه الكلمات إلى أناسٍ مصممين على عدم الإيمان فلماذا يقول لهم “ستطلبونني“؟ حسنًا، توجد طرق كثيرة لطلب يسوع، بكونه الكلمة والحق والحكمة. لكن… “الطلب” أيضًا يستخدم أحيانًا عن الذين يخططون ضده كما جاء في العبارة: “طلبوا أن يمسكوه، ولم يلقِ أحد يدًا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد (يو٧: ٣٠). وأيضًا في العبارة: “أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني، لأن كلمتي لا موضع لها فيكم” (راجع يو٨: ٣٧). وفي العبارة: “ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم الحق الذي سمعه من الآب” (راجع٨: ٤٠) لهذا فإن العبارة “ستطلبونني…“ مقدمة للذين يطلبون بطريقة خاطئة وليس نقضًا للقول: “من يطلب يجد” (مت٧: ٨). يوجد دائمًا اختلافات فيما بين الذين يطلبون يسوع. ليس الكل يطلب بطريقة سليمة لأجل خلاصهم وللانتفاع به.
- “تموتون في خطاياكم“. إن أخذت بالمعنى العادي الواضح أن الخطاة سيموتون في خطاياهم، وأما الأبرار ففي برهم. لكن إن أُخذ تعبير “ستموتون” بخصوص الموت لعدو المسيح (١كو١٥: ٢٦) حيث أن من يموت يرتكب “خطية تقود إلى الموت” (١يو٥: ١٦)، فمن الواضح أن الذين وُجهت إليهم هذه الكلمات لم يكونوا قد ماتوا بعد. ربما تسأل كيف أن الذين لم يؤمنوا وهم أحياء سيموتون في وقتٍ ما. يجيب أحدهم ويقول إنهم إلى ذلك الحين لم يؤمنوا، ولم يخطئوا للموت، والذين لم تأتِ بعد إليهم الكلمة لم يرتكبوا خطية الموت. إنهم أحياء يعانون من المرض في نفوسهم، وهذا المرض ليس للموت (يو١١: ٤).
- لنهتم ألا يصيبنا “مرض للموت“، فمرضنا يمكن أن يُشفى (بالتوبة)، وهو متميز عن المرض الذي لا يُمكن شفائه (بالإصرار على عدم التوبة).
- لنقارن عبارة حزقيال: “النفس التي تخطئ تموت” (حز١٨: ٢٠) بالقول: “ستموتون في خطاياكم“، لأن الخطية هي موت النفس. لست أظن أن هذا صحيح لكل خطية بل للخطية التي يقول عنها يوحنا أنها للموت (١يو٥: ١٦)
- لنميز أيضًا بين خطية هي موت للنفس، وأخرى هي مرض لها. وربما يوجد نوع ثالث للخطية هي فقدان للنفس، هذه التي تشير إليها الكلمات: “ماذا ينتفع الإنسان إن ربح العالم كله وخسر نفسه؟” (مت١٦: ٢٦)؛ (لو٩: ٢٥). وأيضًا الكلمات: “إن احترق عمل أحد فإنه يعاني من الفقدان” ( راجع (١كو٣: ١٥).
“حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا“… فإنه حين يموت أحد في خطيته لا يقدر أن يذهب حيث يذهب يسوع، إذ لا يقدر ميت أن يتبع يسوع. “لأن الأموات لا يسبحونك يا رب، ولا الهابطين في الهاوية، بل نحن الأحياء نحمدك يا رب” (مز113: 25 – 26).
- ظهر سلطانه أن يموت بإرادته الحرة تاركًا الجسم خلفه من العبارة: “أمضي أنا“
- ربما جاء في التقاليد (اليهودية) عن المسيح أنه يولد في بيت لحم، وأنه يقوم من سبط يهوذا حسب التفاسير السليمة للكلمات النبوية؛ وأيضًا في التقاليد بخصوص موته أنه ينتزع نفسه من الحياة بالوسيلة التي قلناها. ويبدو أن اليهود عرفوا أن الذي يرحل هكذا يذهب إلى موضع لا يمكن أن يذهب إليه حتى الذين يفهمون هذه الأمور. لذلك لم يتحدثوا بطريقة حرفية عندما قالوا: “ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟”
- على أي الأحوال أظن قد قالوا هذا عن خبث ما قد بلغ إليهم بالتقليد عن موت المسيح. وعوض أن يمجدوا ذاك الذي يرحل من الحياة بهذه الطريقة قالوا: “ألعله يقتل نفسه؟“.
- ربما في تردد تكلموا، لكن مع تلميح لمجده في لحظات موته، فإنهم كمن يقولون: “هل تفارق نفسه حينما يريد حين يُترك الجسم خلفه؟” هل لهذا السبب قال: “حيث أنا أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟“.
- تأملوا أيضًا إن كان بولس قد قال أمرًا مشابهًا لهذا: “أسلم نفسه لأجلنا ذبيحة لله” (أف٥: ٢)
على أي الأحوال يمكن لمن هو من أسفل ومن هو من هذا العالم، ومن الأرض أن يتغير ويصير من فوق ولا يعود يكون من هذا العالم… لذلك يقول لتلاميذه: “كنتم من العالم، وأنا اخترتكم من العالم، ولستم بعد من العالم” (راجع (يو١٥: ١٩). فإن كان المخلص قد جاء يطلب ويخلص ما قد فُقد (لو١٩: ١٠)، إنما جاء لكي ينقل الذين من أسفل والذين سُجلوا كمواطنين بين الذين هم من أسفل إلى الذين هم من فوق. فإنه هو الذي نزل طبقات الأرض السفلى من أجل الذين هم هناك (أف٤: ٩، ١٠). لكنه أيضًا صعد فوق كل السماوات، وأعَّد طريقًا للذين يرغبون فيه، وقد صاروا تلاميذ حقيقيين له حيث الطريق الذي يقود إلى الأمور التي فوق السماوات أي الأمور غير المادية.
- انتبهوا، إن أردتم أن تتعلموا من الكتاب المقدس من هو من أسفل، ومن هو من فوق. إذ أن كنز كل شخص يوجد في قلبه (مت٦: ٢١)، فإن من يخزن كنزه على الأرض (مت٦: ٢١) بفعله هذا يكون من أسفل. وأما إذا خزن أحد كنزه في السماء (مت٦: ٢٠) يولد من فوق ويأخذ صورة السماوي (يو٣: ٣) ؛ (١كو١٥: ٤٩). بالإضافة إلى أنه إذ يعبر هذا الشخص خلال السماوات يوجد قد بلغ هدفه الطوباوي للغاية.
- يمكن القول أن من هو من أسفل يمارس أعمال الجسد، وأما من هو من فوق فيحمل ثمار الروح (غلا٥: ٢٢). مرة أخرى يُمكن القول أن الذي من هذا العالم يحب هذا العالم، حيث أن الذي له محبة الله هو من فوق كقول يوحنا (١يو٢: ١٥). إنه ليس من هذا العالم ذاك الذي لا يحب العالم ولا الأشياء التي في هذا العالم، إنما يقول: “حاشا لي أن أفتخر إلاَّ بصليب ربي يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي، وأنا للعالم” (راجع (غل٦: ١٤- ١٦).
إن كان الذي لا يؤمن أن يسوع هو المسيح يموت في خطاياه، فمن الواضح أن الذي لا يموت في خطاياه يؤمن بالمسيح. لكن الذي يموت في خطاياه حتى إن قال أنه يؤمن بالمسيح، فإنه لا يؤمن به وهو مهتم بالحق، إن كان إيمانه المشار إليه ينقصه الأعمال، فإن مثل هذا الإيمان ميت كما نقرأ في الرسالة المتداولة كعمل يعقوب (يع٢: ١٧).
- إذن من هو ذاك الذي يؤمن أو يقتنع بأن يحمل طابعًا يتفق مع الكلمة ويتحد معه فلا يسقط في الخطايا التي يُقال أنها للموت (١يو٥: ١٦)، ولا يخطئ – كما جاء في تلك الكلمات – بأية وسيلة مقاومًا الكلمة المستقيمة حسب العبارة: “من يؤمن أن يسوع هو المسيح وُلد من الله” (راجع (١يو٥: ١).
- من يؤمن بالكلمة أنه منذ البدء مع الله (يو١: ١)، فإنه إذ يتأمل فيه لا يفعل أمرًا غير عاقل.
ومن يؤمن أنه هو سلامنا (أف٢: ١٤) لا يود أن يتنازع في شيء ما كمن هو مولع بالحرب أو مثير للشغب.
بالإضافة إلى ذلك إن كان المسيح ليس هو حكمة الله فحسب بل وقوة الله (١كو١: ٢٤)، فإن من يؤمن به أنه القوة لن يكون هزيلًا في صنع الخيرات…
وإذ نعتقد فيه أنه الثبات والقوة على أساس القول: “والآن ما هو ثباتي (رجائي)؟ أليس هو الرب؟” (راجع (مز٣٩: ٨)… فإن سلمنا أنفسنا للمتاعب لا نؤمن به مادام هو الثبات، وإن كنا ضعفاء لا نؤمن به أنه القوة.
الذين سمعوا ما قاله الرب بسلطانٍ عظيمٍ التزموا أن يسألوه من هو هذا الذي ينطق بهذه الأمور. فإنه إذ يعلن المخلص: “إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم” ظهر أنه أعظم من إنسان، إنه يحمل بالأكثر طبيعة إلهية.
ضرورة الإيمان وسموه – للقديس غريغوريوس النيسي[4]
لقد ابتعد أبناء هذا الجيل جداً عن إيمان أبيهم إبراهيم. ولكن حينما تشرح سرالتاريخ الذى سطره سفر التكوين عن حياة أبينا إبراهيم، وحينما تقارن ذلك بما قاله لنا بولس الرسول “بالإيمانِ إبراهيمُ لَمّا دُعيَ أطاعَ أنْ يَخرُجَ إلَى المَكانِ الذي كانَ عَتيدًا أنْ يأخُذَهُ ميراثًا، فخرجَ وهو لا يَعلَمُ إلَى أين يأتي. بالإيمانِ تغَرَّبَ في أرضِ المَوْعِدِ كأنَّها غَريبَةٌ، ساكِنًا في خيامٍ مع إسحاقَ ويعقوبَ الوارِثَينِ معهُ لهذا المَوْعِدِ عَينِهِ. لأنَّهُ كانَ يَنتَظِرُ المدينةَ التي لها الأساساتُ، التي صانِعُها وبارِئُها اللهُ. ” (عب١١: ٨- ١٠) .
فنحن هنا نستطيع أن نتتقل من المعنى الحرفي إلى المعنى المجازي، لأن ابراهيم بعد سماع الوصية الألهية ذهب من أرضه وعشيرته، ولكن كانت الهجرة بالنسبة له كنبي هدفها هو طلب معرفة الله. ولم تكن الهجرة جسدية ولكنها روحية لمعرفة الأشياء التي تكتشفها الروح، فكانت الهجرة بالنسبة لابراهيم هي خروج من الذات ومن العالم الزائل والأفكار الأرضية ثم رفع إبراهيم عقله على إمكانه فوق الحدود العامة للطبيعة البشرية وتخلى عن تعلقات الحواس، وأصبح عقله نقياً لإدراك ما هو غير مرئي، ولم يعد السمع أو النظر يسبب خطأ الفكر. وهكذا يقول الرسول بولس “لأنَّنا بالإيمانِ نَسلُكُ لا بالعيانِ” (٢كو٥: ٧).
لأن ابراهيم أب الآباء ارتفع فوق المعرفة وفاق حدود الكمال البشري وجاهد وعرف الله حسب إمكانياته وهكذا دعى الله مصدر الخليقة كلها أله إبراهيم لأن البشر عرفوا الله عن طريق إبراهيم. وهكذا يقول الانجيل “بالإيمانِ إبراهيمُ لَمّا دُعيَ أطاعَ أنْ يَخرُجَ إلَى المَكانِ الذي كانَ عَتيدًا أنْ يأخُذَهُ ميراثًا، فخرجَ وهو لا يَعلَمُ إلَى أين يأتي” (عب١١: ٨).
ولم يعرف إبراهيم أولاً اسم الذى دعاه وهو لم يخز أو يضطرب بسبب جهله هذا وقد توقف عن المعرفة الأرضية ولا تعلق فكره بأي شيء على الأرض فابراهيم تفوق في الفهم والحكمة عن كل أهل جيله وفلسفة الكلدانيين المعروفة وقتئذ وأنه فاق كل ما يمكن ادراكه بالحواس وكل جمال جسدى آخر، ولذلك أبصر الجمال الإلهى الأصلي وأبصر كل ما يمكن أن ينسب إلى الله من صفات مثل البر والقدرة على عمل أي شيء في الوجود الذاتي والحب. لقد فهم إبراهيم كل هذا حينما تقدم في الفكر وأخذ كل هذا كمئونة في رحلته إلى السماء، وهو تقّوى بالإيمان وطبع كل هذا في قلبه وارتفع فوق مستوى رؤية الأشياء المادية.
إن إبراهيم فاق بزيادة كل ما يمكن أن يصل اليه البشر من البر وتنقى من كل شيء يعوق الإيمان ووضع أمامه معرفة الله وارضائه والتحرر من كل خطأ، وأدرك أن الإيمان يفوق المعرفة والرمز. ولكن بعد هذه النشوة الروحية التي وصل اليها من هذه الرؤية العالية رجع إلى الطبيعة الضعيفة وأعترف أنه مجرد “تراب ورماد” (تك١٨: ٢٧).
والتراب والرماد رمزان للموت وعدم الثمر. وهذا هو الإيمان الذى يجب أن نتبعه لأننا تعلمنا من حياة إبراهيم أن الذين يتقدمون في الطريق الروحى لا توجد أية وسيلة يقتربون بها إلى الله سوى الإيمان، وعن طريق الإيمان فقط تستطيع الروح أن تتحد مع الله غير المدرك وهذا ما قاله بولس الرسول عن إبراهيم أنه “آمن بالله فحسب له براً” (رو٤: ٣).
وأن ما كتبه بولس الرسول ليس من أجل إبراهيم بل من أجلنا، لتعليمنا أنه بواسطة الإيمان وليس المعرفة يتبرر البشر أمام الله لأن المعرفة لها قيمة بالنسبة لصاحبها فقط ولكن هذا ليس بالنسبة للإيمان المسيحي الذي هو “الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى” (عب١١: ١). فهنا الإيقان بأمور غير معروفة، لأننا دائماً لا نرجو الأشياء التي نملكها أو نعرفها “لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه” (رو٨: ٢٤).
فالإيمان هنا يكمل كل ما نقص من معرفتنا، ويمنحنا كل ما هو غير مرئى هكذا يقول الرسول بولس “بالإيمان تشدد كأنه يرى من لا يُرى” (عب١١: ٢٧). ولكن الانسان الذى يظن أنه يمكن أن يدرك الله عن طريق المعرفة هو إنسان غبي لأنه كيف يستطيع الإنسان أن يقارن نفسه بالله أو يدركه بعقله “لأنه من في السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله. إله مهوب جداً في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله” (مز٨٩: ٦- ٧). وهذا معناه أن الأمكانيات البشرية هي ضعيفة ولا تستطيع أن تقودنا إلى معرفة الله.
وهكذا يقول مشورة الجامعة “لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق الكلام قدام الله. لأن الله في السموات وأنت على الأرض” (جا٥: ٢). وهو يشير بذلك إلى المسافة التي تبعد بين السماء والأرض، وهذا يشير إلى مدى بعد الطبيعة الألهية عن أفكار البشر رغم الألفة المتبادلة بين الله والأنسان. وكما تبعد نجوم السماء عن أصابع البشر، فإن الطبيعة الإلهيه تبعد وتفوق عن أفكار البشر أضعاف أضعاف هذا.
عظات آباء وخدام معاصرون :
من أنا في نظرك ؟ العظة الاولي يوم الجمعة من الأسبوع الخامس لقداسة البابا تواضروس
(يو٨ : ٢١ – ٢٨)
من أنا في نظرك ؟
تقابـل السيد المسيح مـع اليهود ، وعنـدما تقابـل معهـم ورأوا معجـزات وحـوارات ومقابلات وسمعوا عظات ، بعد كل هذا سألوه : ” من أنت ؟” وأرجـوك لا بد أن تنتبـه وتأخـذ السـؤال بطريقـة جـادة ، فمـن العجيـب أن الذين جلسوا معه وقتاً طويلاً ، لم يعرفوها وكلمة الله تطرح علينا سؤالاً في هذا النص الإنجيلي مأخوذا مـن سـؤال اليهود للمسيح، فسألوه: ” من أنت ؟” واليوم السيد المسيح يسألك : ” من أنا في نظرك ؟”
أريدك أن تعرف هذه المعلومة الهامة وهي إذا سألنا : ” ما هي المسيحية ؟” والإجابـة المختصـرة عـن هـذا السؤال هـي أن المسيحية سماوية المنشأ ، وسماويـة المقصد . فالمسيحية سماوية المنشأ بمعنى أن نقطة البدايـة فيهـا مـن السماء ، ونقطة النهاية فيها في السماء. فهي سماوية المنشأ من وقت ما قال الكتاب : ” أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ، لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية ” (يو ٣ :١٦). فالله الذي في السماء أحب العالم الموجود في الأرض وهذه نقطة البداية ، وأحب الله العالم ” حتـى بـذل “، وبذل هنا أي الصليب ، فكأن الحـب عبـر عنـه كتعبير عملي على الصليب ، ” لكي لا يهلك كل من يؤمن به ” أي من يؤمن بالمسيح ، فلا هلاك لـه ” بـل تـكـون له الحياة الأبدية “، وهنا ندخل السماء ، لقد بدأنا من السماء ووصلنا السماء ، وهذا يعني أن رحلة الإنسان المسيحي صحيح سماوية، لكن هذا حسب جهاده الروحي والتفاته حول حياته الروحية فتكون له السماء، لكن إذا كان هناك مـن هو غير ملتفت لحياته الروحية ولا منتبه لها فكيف تكون له السماء ؟
ولذلك اليهود عندما تكلمـوا مـع المسيح وضـع لهـم عبـارة سهلة جداً ، وقال لهم : ” أنتم من أسفل ، أما أنا فمـن فـوق . أنتم من هذا العالم ، أما أنا فلست من هذا العالم ” (يو ٨ : ٢٣)، وبالتأكيد يقصد السماء ، فإجابة المسيح تكشف سماوية المسيحية .
هذه البداية مهمة لكي تعرف لماذا سأل اليهود هذا السؤال بالرغم من أنهم عاشوا مع المسيح فترة طويلة ، ورأوا المعجزات والتعاليم والأمثال والزيارات التي تممها السيد المسيح ، ما هذا القلب الصلب المغلق ؟
لذا لا بد أن نطرح الأمر أكثر وضوحاً ، والسؤال : لماذا لم يعرف اليهود الذين سألوا هذا السؤال شخصية المسيح ؟
١- لأنهـم مـولـودون بالخطيـة ، فـكـل إنسـان مـولـود بالخطية ؛ لأن رأس البشرية أخطأ ، والسيد المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية ، وقد عرف داود النبي الخطية في المزمـور الذي تصليه : ” وبالآثام حبل بي ، وفي الخطية ولدتني أمي ” (مز ٥١ : ٥ ) فأصبح كل إنسان يحمل هذه الوصمة ، ومن آدم إلى نهاية الخليقة ينطبق عليهم مقولة داود النبي . لذلك تُعلّمنا الكنيسة إننا نقوم بمعمودية الطفل وهو صغير جدا ، بالرغم من أنه لا يعي شيئاً ، حتى ينال مسح هذه الخطية ، أما اليهود في هذا النص الإنجيلي فليسوا فقط مولودين بالخطية بل يعيشون أيضا فيها . إذا ما يجعل الإنسان لا يعرف شخص المسيح هو قلبه المملوء بالخطية ، حتى إذا كان مسيحياً ، فإذا كان في القلب خطية فهي تجعل القلب قاسياً لا يعرف ولا يفهم ، والمعجزة قد تتم أمامه ولكنه لا يستفيد منها .
٢ـ إنهم في نفس الوقت كانوا محبين للأرض والعالم ، ولم يفكروا في السماء ، فهناك من يحب العالم وبكل ما فيه ، ومحبته للعالم قد تنسيه السماء .
- مثال
رجـل غـني لديه خيرات كثيرة ، ولكـن كـان بجـوار هذا القصر إنسان معـدوما فقيرا ، وكلمـة بجـواره تعني أن الغـنـي يـرى الفقير باستمرار أثناء دخوله وخروجه ولكنه لم يتحنن على هذا المسكين ، حتى أن الكلاب جاءت تلحس قـروح هذا الرجل وكأنها تعمل عملاً خفياً ، حيث تُخفف آلامه . محبة الأرضيات تجعل قلب الإنسان لا ينظر لفـوق ، أو على الأصح لا يمكن أن يفهم الصـواب ، لذلك اليهـود ذهبـوا للسيد المسيح وسـألوه : ” مـن أنـت ؟”، فالسـبـب هـو محبتهم الشديدة للأرضيات وكل ما فيها .
تعلمنا الكنيسة باستمرار فـي كـل قداس وفي نهاية الكاثوليكون ” لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم “، وهذه الوصية تقدمها الكنيسة كأم تكرر الوصية على أولادها ، وهذه هي التربية الناجحة ، فأرجو أن تنتبه أن هذا لا يعني أن نتخلى عن مسئوليتنا أو أعمالنا ، لكن مستوى العمل أو مسئوليتنا يجب أن يتوافق مـع مـا فـي السماء وليس الأرض .
٣- كانوا يضيعون الفرص ، فدائماً الإنسان الذي يضيع الفرصة هو الخسران ، خاصة الفرص الروحية ، فهو يخسر كثيراً ، والفرصة تأتي وراء الأخرى ، وتعلمنا الكنيسة يوم جمعة ختام الصوم وتختار الإنجيل الذي يتكلم فيه المسيح ويقول لليهود : ” يا أورشليم ، يا أُورشليم ! يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تُريدوا !” (مت ۲۳ : ۳۷)، اسمع ” كم مرة أردت ” وهذا يعني أن الله يضع أمامنا الفرص ، وكلمة ” كم مرة ” تعني أنها غير معدودة ، فكانت فرصة وراء فرصة ، وأنت تضيعها . هذا قد تأتيك فرصة للاعتراف أو لحضور القداس أو حضور اجتماع أو لتقرأ الإنجيل ولكنك تضيع الفرصة ، وترجع تسأل : ” من هو المسيح ؟”.
اليهود سقطوا في هذه الضعفات ، وأضاعوا الفرص التي كانت أمامهم . ونتيجة من يضيع الفرصة منه أنه لا ينمو في حياته الروحية . اسمع داود النبي يقول : ” اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك ” (مز ١١٩ : ١٨)، وهذا يعني أن عيني قلبي تكون مفتوحة دائما لترى ما وراء الكلمات ، ولا تُضيع الفرصة. من نکه تسما مـن الأمـور الجميلـة فـي تاريخنـا المصـري المسيحي أننا نتباهى بالرهبنة والأديـرة والقديسين وحياة الآباء والصلوات . والرهبنة فرصة ، كان الشماس يقرأ الإنجيل ، والشاب أنطونيوس حاضـر ويسمع كـلام الإنجيـل : ” إن أردت أن تـكـون كـاملاً فاذهـب وبـع أملاكـك وأغـط الفقراء، فيكـون لـك كنـز فـي السـماء ، وتعـال اتبعنـي ” (مـت ۱۹ : ۲۱)، لقـد اعتـبـر الشـاب أنطونيوس أن هذه الكلمات كتبت خصيصاً له ، وابتدأ يتجه إلى البرية ، ومرحلـة تلـو مرحلة إلى أن تأسس نظام الرهبنة . إنها فرصة ، ضع أمامك الفرص ؛ لأنه إذا فقدت هذه الفرص ، فسوف يتحجر قلبك .
ثلاثة عوامل جعلت اليهود يسألون السيد المسيح مـن أنـت ؟ بعـد كـم المعجزات والآيات والتعاليم التي قدمها ، لذا أرجـوكم تستشعروا خطورة هذا السؤال : ” مـن أنت ؟” لذلك يطرح عليك السيد المسيح هذا السؤال : من أنا في نظرك ؟
لذلك أضع أمامك عدة نماذج من الإجابات :
۱ـ مسيح الخـوف : قـد يكـون المسيح فـي نظـر إنسـان هـو مسيح الخـوف ، المسيح الذي ينتظر دائماً أخطاءك . ويعيش الإنسـان فـي خـوف دائـم وكأنـه مـراقـب مـن المسيح الذي ينتقم أو يعاقب ، فهذه العلاقة يمكن أن ( يبطش ) ( ينتقم نسميها ” علاقة الخوف ” وليست المخافة .
۲ـ مسيح الأجـرة : هنـاك شـخص آخـر علاقته بالمسيح ( مسيح الأجرة )، بمعنى أعمل الشيء مقابل أنك تعمل لـي شـيئاً ، فمثلاً أنـا ” أصـلـي لـك ” مقابل أن تتمم لـي مسيح ست معجزة ، ومسيح الأجرة كأنك فـي عمـل تجاري مع المسيح وتنتظر المكافأة وتـؤدي الصلوات والطقوس أو القوانين الروحية انتظـاراً لفائدة خاصة أو لمعجزة أو لاستجابة معينة في ذهنك . ليست هذه العلاقة الحقيقية مع المسيح .
٣- ” مسيح الحب “، قد تعتبر هذه الإجابة هي الإجابة الأمثل وهى ” مسيح الحب ” عندما يسألك المسيح : ” من أنا في نظرك ؟”، تقول له : ” كل الحب ، كل المحبة “.
المسيح هو الصديق والرفيق ، ورحلة حياتك تكون أكثر حلاوة إن كان المسيح هو رفيقك وصديقك في كل صغيرة وكبيرة ، في كل صباح ومساء ، في كل مرحلة
وكلمة المسيح الصديق والرفيق معتمدة أو مبنية على المسيح الفادي والمخلص ، هو صاحب الصليب الذي قدم لي أغلى هدية وهي الفداء والخلاص . هذه الصورة هي المفترض أن تنطبـق فـي أذهاننا ، فإذا سألك المسيح : ” مـن أنـا فـي نـظـرك ؟” تقـول لـه : ” يا يسوع أنت فادي ومخلصي ، أنت صديقي ورفيق حياتي “، وهذه هي الإجابة الأمثل .
والمسيح قال لنـا فـي وصية جميلة : ” ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر ” (مت ۲۸ : ۲۰). الله حاضر معك دائماً ، ولا بد أن تنتبه أنه أحيانا هناك شخص يكون المسيح رفيقه داخل الكنيسة ، وعندما يخرج ينساه ويعتمد على ذراعه وعضلاته ومعرفته وإمكانياته . فهل المسيح رفيقك في كل خطوة وفي كل قرار ؟ ت يقول القديس معلمنا بولس الرسول : ” فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً ، فافعلوا كل شيء لمجـد الله ” (۱ کو ۱۰ : ۳۱)، حتى الأكـل فـهـو عمـل كـل يـوم ، أيضاً شرب الماء ، فأنت عندما تشرب الماء قل له : ” يا رب أشكرك لأنك وفـرت لـي الماء فيوجد آلاف من البشر ليس لديهم ماء “، لذلك نقطة الماء غالية جداً ، وأيضاً الطاقة ، هناك بلاد كاملة ليس فيها طاقة كهربائية ، وبالتالي النعم التي يسكبها الله عليك هي لأن الله رفيقك في كل يوم.
ولكـن تـوجـد إجابـة أخيرة صعبة جدا إذا سألك المسيح : “مـن أنـا فـي نـظـرك ؟” فأحياناً يـرى الإنسان المسيح غائبـاً وليس حاضـراً ، قـد تـسـمـع عـن بعـض الضعفات أو العنف الذي يحدث في أي مجتمع ، ويقف الشخص أمام ربنا ويقول له : ” أين أنت يا رب ؟ لماذا تغيب عني ؟” ولكن أوضح لك أن الله لا يغيب ، وإنما يعمل ، وفي الوقت المناسـب تـرى عمله ، ليس في حسب فكرك أنت ، ولا حسب كلامك ، ولا حسب رؤيتك أنت .
- الخلاصة :
إذا كان اليهود اليوم بعد ما سمعوا عن المسيح وشاهدوا معجزاته ، يسألونه : ” مـن أنت ؟” ولم يستطيعوا أن يعرفوه ، فاعرف أن خطاياهم هي التي صنعت هذا فيهم ، اعرف أنهم ولدوا بالخطية وعاشوا فيها ، وأنهـم أحبـوا الأرضيات ، وأضاعوا الفرص الكثيرة أمامهم، فاحترس ولا تضيع الفرصة ، ولا بد أن تعرف أن مسيحك رفيقك وصديقك ، وهو فاديك ومخلصك . فليعطنا مسيحنا أن تُدرك حضـوره الـدائـم معـنـا فـي كـل أمـور حياتنا ، وننتظر عمله العجيب.[5]
العظة الثانية الإيمـــان – للأنبا يؤانس أسقف الغربية[6]
في الاعداد لرحله الطريق الي الله، يأتي الإيمان. لكن ماذا يمكن أن نقوله عن الإيمان، الذي قال عنه الرسول بولس: إنه بدون إيمان لا يمكن ارضاء الله (عب١١: ٦)، “وكُلُّ ما ليس مِنَ الإيمانِ فهو خَطيَّةٌ” (رو١٤: ٢٣).
أيها الأخوة .. إن الطريق إلى الله يحتاج بلا شك إلى الإيمان، فالطريق هو إلي الله، والإيمان هو بالله وفي الله ..
فما هو هذا الإيمان الذي نحتاجه ونحن نعد لرحلة الطريق؟
لقد قدم بولس الرسول تعريفا محدداً للايمان قال: “الإيمانُ هو الثِّقَةُ بما يُرجَى والإيقانُ بأُمورٍ لا تُرَى” (عب١١: ١) ..
الإيمان ثقة، ولأنه ثقة بالله، لذا “فكُلُّ ما ليس مِنَ الإيمانِ فهو خَطيَّةٌ” .. لأن عدم الثقة في الله اهانة له … إذا حدث وقال إنسان لآخر إني لا أثق بك، أو لا ثقة لي فيك، ألا تعتبر هذه إهانة كبيرة لذلك الإنسان؟!… وحتي لو لم نتجرأ ونقول هذه الكلمة لله أو عنه، لكنه يعرف الخفايا والسرائر..
الإيمان هو اليد التي تأخذ ما تريده من الله .. هي اليد التي يتعامل الله معها، وبها نأخذ كل عطاياه … إذا أراد إنسان أن يعطي آخر شيئاً ما، فعلى هذا الآخر ان يمد يده ويبسطها لكي ما يأخذ هذا الشيء .. من جهة الله هو مستعد أن يعطيك كل شيء مقابل شيء واحد هو الايمان!!، الم يقل المسيح بفمه الإلهي الطاهر “كُلُّ ما تطلُبونَهُ في الصَّلاةِ مؤمِنينَ تنالونَهُ” (مت٢١: ٢٢) .. لقدأعطي الله الإيمان كل القوة، وكل الفاعلية أن يأخذ كل ما يريده.
على أن فشل البعض في الحصول على طلباتهم من الله – رغم ادعائهم بالإيمان – إنما يرجع لبعض الأسباب .. لا بد وان يكون الإيمان كاملاً ..
ولكي يكون الإيمان كاملاً: لا بد وأن تتوافر له ومعه بعض العناصر..
أ- الشعور بوجود الله:
أول ما ينبغي توفره في الإيمان هو الشعور بوجود الله .. نحن في رحلة طويلة وسائرين فيها، ولا نعلم ماذا يصادفنا خلالها، لذا فإن الأمر يتطلب إيماناً بالله .. يقول معلمنا بولس الرسول: “ولكن بدونِ إيمانٍ لا يُمكِنُ إرضاؤُهُ، لأنَّهُ يَجِبُ أنَّ الذي يأتي إلَى اللهِ يؤمِنُ بأنَّهُ مَوْجودٌ، وأنَّهُ يُجازي الذينَ يَطلُبونَهُ ” (عب١١: ٦) – وسوف نعرض لهذه النقطة بإسهاب ونحن نعالج موضوع رفاق الطريق – إن الله يرافقنا في هذا الطريق مع رفاق آخرين .. “لأنَّهُ يَجِبُ أنَّ الذي يأتي إلَى اللهِ يؤمِنُ بأنَّهُ مَوْجودٌ”.
ما معني أن الله موجود؟ ما معني الشعور والإحساس بوجود الله؟..
نقول الله موجود، وربنا موجود .. نعم، الله موجود، لكن المقصود هنا ليس المعنى اللاهوتي أن الله موجود في كل مكان .. إنما موجود هنا تعني أنه ينظر ويعتني ويتصرف وينتقم إذا تطلب الأمر الإنتقام، ويحفظ إذا لزم الحفظ، ويستر إذا إحتاج الأمر إلى الستر، ويشجع في حالة الحاجة إلى التشجيع، ويبعث الرجاء في النفس في حالة الإفتقار إلى الرجاء.
نعم الله موجود “لأنَّهُ يَجِبُ أنَّ الذي يأتي إلَى اللهِ يؤمِنُ بأنَّهُ مَوْجودٌ“. هناك بعض الناس في أوقات الضيق والتجارب يقولون نريد أن نرى أين الله – فين ربنا ده – الإنسان كاد يكفر أين هو الله، ولو كان فيه ربنا كان يحصل كدة…الخ. مثل هؤلاء الناس لا يشعرون أن الله موجود. ولو أن الله أعطاهم كل رغباتهم لكان بالفعل موجوداً، حتي لو كانت هذه الرغبات خاطئة. ومن المستحيل أن يحقق الله رغبات خاطئة، أو يعطي الإنسان ما ليس لخلاص نفسه.
على أي الحالات، فإن الشعور بوجود الله عنصر من عناصر الإيمان .. هو تدريب شيِّق وقوي ونافع جداً، لأنه يمنع الإنسان من الزلل. إنه يحس بأن الله موجود – ليس فقط ليتشجع بهذا الشعور والإحساس – بل موجود وناظر إليه ويرقب كل تصرفاته .. وهذا وحده كافٍ لردع الإنسان ومنعه من الخطأ. وما أبلغ العبارة التي قالها المرنم:
“جعلت الرب أمامي في كل حين. لأنه عن يميني فلا اتزعزع” (مز١٦: ٨) .. وطالما هو موجود، فإنه يمنع الأضرار، ويوقف المصائب ويبعد عنا الكوراث .. هذا هو الإيمان ببساطة .. هذا عن العنصر الأول الخاص بالإحساس بوجود الله .. أما العنصر الثاني فهو الثقه في الله.
ب- الثقة في الله:
الإيمان هو أن يثق الإنسان في الله، وفيما يطلبه منه .. تعالوا نقيِّم ثقتنا بالله كبشر.
إنه لأمر مخجل حقاً أن يثق المريض في طبيبه أكثر من ثقته بالله. وأن يثق المسافر في سائق العربة أو القطار أو الطائرة ثقة تفوق ثقته بالله .. الإنسان يركب وسيلة المواصلات أيا كانت، وينشغل بالقراءة أو أي شيء آخر، وهو واتقان السائق سوف يصل به إلي حيث يريد!! إنه أمر مخجل حقاً أن نثق ببعض الناس أكثر من ثقتنا بالله!! لماذا هذا؟!..
لقد أعطانا الله مواعيد عظمى وثمينة (2بط ١: ٤) .. ها إن الله قد أعطاك كل شيء. أعطاك سلطاناً على السماء والأرض .. إن الله لم يعطنا الجزء، بل أعطانا الكل بواسطة الإيمان .. إنسان محتاج يطلب من إنسان ثري أن يقرضه مبلغاً من المال فيقول له ذلك الثري الطيب سوف لا أعطيك المبلغ الذي تطلبه، بل سأعطيك مفتاح خزانتي لتأخذ منها ما تريد!! هكذا يتعامل الله معنا..
ألم يقل المسيح له المجد “اِسألوا تُعطَوْا. اُطلُبوا تجِدوا. اِقرَعوا يُفتَحْ لكُمْ. 8لأنَّ كُلَّ مَنْ يَسألُ يأخُذُ، ومَنْ يَطلُبُ يَجِدُ، ومَنْ يَقرَعُ يُفتَحُ لهُ” (مت٧: ٧ ،٨) .. “ومَهما سألتُمْ باسمي فذلكَ أفعَلُهُ ليَتَمَجَّدَ الآبُ بالِابنِ. إنْ سألتُمْ شَيئًا باسمي فإنِّي أفعَلُهُ” (يو١٤: ١٣، ١٤). وأمام هذه المواعيد العجيبة، هناك إحتمالان: فإما أن الله غير صادق في مواعيده، وإما أن هناك عيباً فينا، أو أننا لا نريد أن نأخذ!! وبطبيعة الحال فإن الله صادق، وحاشا له أن يكذب (رو٣: ٤).
“السَمَاءُ والأرضُ تَزولانِ ولكن كَلامي لا يَزولُ” (مت٢٤: ٣٥) .. هذه هي مواعيد الله .. إذن لا بد وأن يكون العيب فينا ..
إن يد الله ممدودة مستعدة لعطائنا، لكننا لا نأخذ .. بابه مفتوح مستعد لدخولنا لكننا لا ندخل. وصوته العالي ينادينا ونحن لا نصغي ولا نسمع أو لا نريد أن نسمع ونقبل إليه!! العيب ليس في الله بل فينا ..
هلم، ثق في الله وكل مواعيده، وتعال وسوف ترى حسن صنيعه معك .. فقط ثق في مواعيده. واتكل عليه من كل قلبك وسترى عجباً..
لكن علينا أن نعرف ونحن نتكلم عن الثقة في الله، أن هناك أعداء للايمان، ومن أعداء الإيمان العقل، بل لعله أكبر الأعداء!!.. ليس معني هذا ان العقل خطية أو تجربة حاشا لنا أن نقول ذلك. لكننا نقصد الإنسان الذي يضع أقوال الله ومواعيده تحت عقله وفحصه، يأخذ منها ما يقبله عقله، ويرفض كل ما عداه .. مثل هذا الإنسان لن يستفيد من مواعيد الله .. لقد امتدح السيد المسيح إيمان الصغار: “الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إنْ لم ترجِعوا وتصيروا مِثلَ الأولادِ فلن تدخُلوا ملكوتَ السماواتِ” (مت١٨ :٣) .. وما ذلك إلاً لأن الصغار عندهم عنصر التصديق، الذي يستند الى البراءة والبساطة. الطفل أو الصغير لا يفكر بعقله، لكنه يسلم بما يُقال له ويصدقه..
هكذا مطلوب منا أن نثق في صدق الله وصلاحه وحبه وعنايته وحدبه “هل تنسَى المَرأةُ رَضيعَها فلا ترحَمَ ابنَ بَطنِها؟ حتَّى هؤُلاءِ يَنسَينَ، وأنا لا أنساكِ” (إش٤٩: ١٥) .. ونثق في أن الله لا ولن يتغير “ليس عِندَهُ تغييرٌ ولا ظِلُّ دَوَرانٍ” (يع١:١٧). و”هو هو أمسًا واليومَ وإلَى الأبدِ” (عب١٣: ٨) .. ومعني أن الله ليس عنده تغيير، أنه كما كان مع آبائنا واسلافنا سيكون معنا .. إن الكتب المقدسة وسير القديسين مليئة بمعاملات الله معهم، وعنايته بهم ورعايته لهم، حتي وهم في شقوق الأرض والمغاير والبراري والجبال .. أما عنصر التغيير فقد حدث فينا، فَقَلَّت ثقتنا في الله أو كادت تنعدم ..
ينبغي أن تكون أحد عناصر ثقتنا في الله أنه صالح ومحب لا ينسى أولاده. ثم نثق في قوته وقدرته وأنه قادر على كل شيء .. إن هذا الكلام يعتبر من البديهيات، لكن الكلام النظري شيء، والإحساس و اليقين بصدقه شيء آخر هوالمطلوب .. إن عبارة “الضابط الكل” التي نسمعها ونرددها، معناها الحرفي في اللغة اليونانية “الكلي القدرة”.. هذا هو الهنا الذي نعبده ونسير خلفه ونتبعه، وهذه هي الثقة التي لنا فيه .. إنه معنا كل الأيام إلي إنقضاء الدهر (مت٢٨: ٢٠).
حدث أن شعب الله قديماً، فيما كانوا يقتربون من شاطئ البحر الأحمر، أنهم رأوا فرعون بمركباته وجنوده وفرسانه، يَجِدّون في اثرهم، إمتلأت قلوبهم هلعاً ورعباً، وارتجفوا وتذمروا على موسى لكن موسى رجل الله قال لهم: “لا تخافوا. قِفوا وانظُروا خَلاصَ الرَّبِّ الذي يَصنَعُهُ لكُمُ اليومَ. …. الرَّبُّ يُقاتِلُ عنكُمْ وأنتُمْ تصمُتونَ” (خر١٤:١٣، ١٤).. إن حادثة البحرالأحمر لم تكن حدثاً تاريخياً وقع وانتهى، لكنه مازال على مستوى الوقع يتكرر من يوم إلى يوم، مازال الله – بنفس الصورة القديمة يعمل معنا، لكن فهمنا ثقيل – ألم يقل المسيح له المجد: “وهذِهِ الآياتُ تتبَعُ المؤمِنينَ: يُخرِجونَ الشَّياطينَ باسمي…. يَحمِلونَ حَيّاتٍ، وإنْ شَرِبوا شَيئًا مُميتًا لا يَضُرُّهُمْ” (مر١٦: ١٧،١٨) .. يجب أن نفهم أننا نحيا بمعجزة، وكل من له حس روحي يستطيع أن يلمس يد القدير وهي تعمل. أنا لا أتكلم عن أحداث مضى عليها مئات السنين، لكني أتكلم عن تاريخنا القريب والمعاصر. والله بهذا المفهوم يتعامل مع شعبه كأفراد و جماعة مؤمنين وكنيسة..
ماذا يقول السيد المسيح أيها الأخوة “لكن اطلُبوا أوَّلاً ملكوتَ اللهِ وبرَّهُ، وهذِهِ كُلُّها تُزادُ لكُمْ. فلا تهتَمّوا للغَدِ” (مت٦: ٣٣ ،٣٤) .. وملكوت الله هنا تعني خلاص النفس “ها ملكوتُ اللهِ داخِلكُمْ” (لو١٧: ٢١). الله يريدنا ألا ننشغل إلا بخلاص أنفسنا، أما الأمور الباقية فقد أخذ الله مسؤليتها .. يعوزنا هذا الإيمان ونحن في رحلة الطريق إلى الله، حتى لا ننشغل بأمور أخرى، أعلن الله تكفله بها ..
هناك عدو آخر من أعداء الايمان هو الشك .. في إحدي المرات أمر السيد المسيح تلاميذه أن يركبوا السفينة ويذهبوا الي عبر البحر، وفي الهزيع الأخير من الليل، رأوه التلاميذ ماشياً على الماء، في البداية ظنوا أنه خيال، فقال لهم “أنا هو لا تخافوا”، فقال بطرس “ياسيِّدُ، إنْ كُنتَ أنتَ هو، فمُرني أنْ آتيَ إلَيكَ علَى الماءِ. فقالَ: تعالَ. فنَزَلَ بُطرُسُ مِنَ السَّفينَةِ ومَشَى علَى الماءِ ليأتيَ إلَى يَسوعَ. ولكن لَمّا رأَى الرِّيحَ شَديدَةً خافَ. وإذ ابتَدأَ يَغرَقُ، صَرَخَ قائلاً: يارَبُّ، نَجِّني!. ففي الحالِ مَدَّ يَسوعُ يَدَهُ وأمسَكَ بهِ وقالَ لهُ: ياقَليلَ الإيمانِ، لماذا شَكَكتَ؟” (مت١٤: ٢٢- ٣١)… ولو لم يشك بطرس لأستمر في سيره على الماء.
وفي يوم اثنين البصخه بعد أن يبست شجرة التينة غير المثمرة بأمر الرب يسوع وبكلمته قال لتلاميذه “إنْ كانَ لكُمْ إيمانٌ ولا تشُكّونَ، فلا تفعَلونَ أمرَ التِّينَةِ فقط، بل إنْ قُلتُمْ أيضًا لهذا الجَبَلِ: انتَقِلْ وانطَرِحْ في البحرِ فيكونُ” (مت٢١:٢١) .. بقدر ما يبدو هذا الإيمان في نظر البعض صعباً، لكننا لا نستطيع أن نخطيء، وننسب لله عدم الصدق في كلامه ومواعيده.
إن عطية الإيمان، وهبة الإيمان، وقوة الإيمان، وما يستطيعه الإيمان إنما هي عطية مجانية لكل إنسان بشرط أن يصدق فقط .. الله يريد أن يعطينا، ويريدنا أن نأخذ، لكن يعوزنا يد الايمان المبسوطة التي تأخذ من الله. أعود واقول إن الإيمان هواليد التي بها نأخذ كل شيء من الله.
ثم ماذا أيها الأخوة .. كان ينبغي أن نتكلم عن شيء آخر، ونحن نعد لرحلة الطريق، وهو شيء مرتبط بالإيمان، لكني سأتحدث عنه بإسهاب في الموضوع القادم “مؤونة الطريق”.. هذا الشيء هو الحب .. والحب والإيمان مرتبطان ببعضهما، يقول رب المجد “الذي عِندَهُ وصايايَ ويَحفَظُها فهو الذي يُحِبُّني، والذي يُحِبُّني يُحِبُّهُ أبي، وأنا أُحِبُّهُ، وأُظهِرُ لهُ ذاتي” (يو١٤: ٢١) .. هذا هو قمة الإيمان الذي يستند الي الحب.
إن الحب والإيمان يسيران جنبا إلى جنب، ويرتبطان ببعضهما إرتباطاً وثيقاً .. لأنه كيف يمكن لإنسان أن يحب من لا يصدقه ولا يثق به (الايمان)، أو كيف يمكن لإنسان أن يثق ويصدق (الإيمان) من لا يحبه؟!..
ألا فليباركنا الله بكل بركة روحية ويعين ضعف إيماننا، ويختم بالبركة على هذه الكلمة آمين.
ما هو الإيمان – الأب ليف جيليه[7]
سوف أتحدث معكم عن الإيمان. أنه موضوع من الصعب معالجته، أقصد من أية زاوية سوف نتحدث عنه إذ أنه من الممكن اعتبار المسائل الإيمانية مجرد مسائل عقائدية، أو سيكولوجية أو اجتماعية أو حتى قانونية.
إذن هناك طرق لمناقشة موضوع مثل هذا. أنا أفضل الحديث عن الإيمان الذي يخبرنا الرب عنه فى الكتاب المقدس. أفضل دائماً كما تعودت، أن أستمع إلى صوت الرب عن الإستماع إلى أي صوت بشري. إذن سوف أتوجه إلى كلمة الله لترشدنا عن طبيعة الإيمان. فكلمة الرب محيط كبير، لجة متسعة. يا ترى فى أي جزء من الكتاب المقدس سنجد ما نبحث عنه؟ ففي العهد القديم نجد كلاماً رائعاً عن إيمان إبراهيم أب الآباء.
لعلنا نستطيع أن نقول، إنه من وجهة النظر المسيحية، أن كل إيمان حي يجب أن يتمثل بالإيمان البسيط الذى كان لإبراهيم. فقد ترك كل شئ بناء على دعوة سماوية، بأمر إلهى متنازلاً عن كل شئ فخرج وهو لا يعرف إلى أين يمضى.
لكنني أفضل البحث عن الإيمان بين صفحات العهد الجديد، فهناك رسائل بولس وبالأخص رسالته إلى أهل رومية موضوعها الرئيسي “الإيمان وسلام الإيمان”.
وإن كنت لازلت أفضل أن أستقى كلمات الإيمان من فم الرب يسوع نفسه فإليه أتوجه بالسؤال “ما هو الإيمان؟”
توجد فى الإنجيل فقرة توضح لنا فكر الرب يسوع. “الحق أقول لكم، لم أجد ولا فى إسرائيل إيماناً بمقدار هذا”
نحن إذن أمام شهادة من فم السيد نفسه. هنا قمة الإيمان، إيمان يشهد له يسوع نفسه “لم أجد إيماناً بمقدار هذا” وحول هذه الفقرة من الإنجيل سوف يدور حديثي معكم يا أحبائي.
سوف أقرأ معكم أولاً نص القديس متى البشير فصل ٨ أعداد ٥- ١٣.
هذا النص يجب أن يوضع فى مقابلة نص آخر لكى نتبين حقيقة ما يقصده الرب يسوع بالإيمان وعدم الإيمان. وهذا النص الآخر من إنجيل (مر٦: ١- ٦).
فى هذين النصين يخبرنا الإنجيل أن الرب يسوع تعجب من أمر ما:
فمن ناحية تعجب يسوع من قائد المئة الرومانى “فلما سمع يسوع تعجب….الحق أقول لكم لم أجد ولا فى إسرائيل إيماناً بمقدار هذا”.
ومن ناحية أخرى تعجب أمام جحود أهل الناصرة “ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة …وتعجب من عدم إيمانهم”.
يخيل إلينا أننا أمام معضلة، فمن ناحية ها هو ضابط رومانى غير يهودي (هو أممى أي وثني) أى أنه لم يكن من شعب الله المختار.
ومن ناحية أخرى نجد أهل الناصرة الذين يمكن أن نسميهم متديني عصرهم، فقد كان لديهم الشريعة – الأنبياء – الطقوس- الهيكل- التراث – التعليم، أي كل السبل التى كان يمكن أن تكفل لهم وجود سلام بينهم وبين الله. ورغم ذلك فقد تعجب يسوع من عدم إيمانهم. وله الحق فى ذلك:
لنتأمل الحالتين:
أولاً: أهل الناصرة: ما الذى كان ينقصهم؟.فإذا اكتشفنا ماكان ينقصهم أمكننا على الفور أن نتبين أسباب قلة الإيمان. فمثال أهل الناصرة يكشف لنا أن الإيمان ليس هو مجرد ممارسات ولا هو اقتناع عقلي محض، ولا أنماط فكرية معينة، ولا هو إتمام فرائض بعينها.
فهؤلاء القوم كانوا متدينين، لقد حضروا إلى المجمع لأنه كان يوم سبت. أي أنهم شاركوا فى الطقوس وحصلوا على التعليم الأسبوعي.
وفي ذلك السبت قُرئت الشريعة وبعض نصوص الأنبياء. كان لديهم عقيدة صحيحة بحسب اليهودية ولكن لم يكن لديهم الإيمان.
الإيمان لا يعنى الإيمان العقلي، فأهل الناصرة كانوا ينتمون إلى المجمع وإلي الهيكل، كما ننتمى نحن إلى الكنيسة الأرثوذكسية، ومع ذلك فقد يحدث أن الكثيرين منا نحن أيضاً لا يكون لدينا إيمان!.
ثانيا: إذن ماهو الإيمان؟ لنرجع إلى قائد المئة فقد كان هناك ما كان ينقص أهل الناصرة الذين كان لديهم كل شئ ما عدا الأساس، ما عدا ما يعطي الإيمان معناه الحقيقي. وطبعاً لن يكون باستطاعتنا مطالبة أهل الناصرة أن يؤمنوا بأسلوب الإيمان فى عصرنا، أسلوب المؤتمرات والندوات التى تبحث طبيعة الله المتجسد ونقتلها بحثاً ودراسة.!
فأهل الناصرة لم يؤمنوا أى لم يفتحوا قلوبهم. وبالطبع فإن قائد المئة كان يعجز عن التحدث عن الفداء وعن الله المتجسد، وربما كان قد سمع عن المسيح اليهودى رغم أن يسوع لم يكن قد اُستعلن كمسيا.
إذن يا أحبائي سوف أُعرِّف الإيمان بهذا المفهوم الذى شرحته:
انفتاح القلب. كيف ينفتح القلب على شخص لا نراه بالعين المجردة، ولكن إذا مثلنا بين يديه، وإذا ركعنا عند أقدامه، نشعر بعظمة مطلقة تجعلنا نتأكد فعلاً أنه يستحق أن يسود على حياتنا، حتى يصبح مالكاً لها، فنستسلم بهدوء وإطمئنان بين يديه. هذا هو الإيمان.
هذا الإيمان ليس بممارسة دينية، بل هو ثقة، هو دفعة قلب.
أعمدة الإيمان :
فلنقترب من هذا الإيمان ونتفحصه عن قرب، فهو بناء قائم على عدة أعمدة. فلنتأمل قليلاً فى تلك الأعمدة:
نرجع إلى المثال الذي اخترناه وهو قائد المئة، نجد أن انفتاح القلب مؤسس أولاً على عمود هام ألا وهو:
المسكنة والاتضاع:
“يا سيد لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي” هذا إعلان بعدم الاستحقاق. إذن لا يوجد إيمان صحيح بدون أتضاع ومسكنة. فالذى يؤمن بيسوع لا يشترط أن يكون مدركاً لكل أبعاد حب يسوع الواسعة، ولكنه يحس بالفعل أن الذي يؤمن به هو بطريقة ما أعظم منه كثيراً جداً، وعنده ما ينقصه هو فلا يسعه إلا أن ينحني ويجثو ويشعر أنه مسكين وصغير.
إذن فكل إيمان ليست له جذور المسكنة والاتضاع والتصاغر عند قبولنا للرب “يا سيد لست أهلاً”، فلن يكون سوى إدعاء. هذا هو حجر الزاوية فى كل ايمان حقيقي.
العمود الثانى الذى يستند عليه الإيمان: هو الذى يجعل الإيمان ممارسة حقة، يجعله فى قوة دافعة، ويكون العقل له دخل جزئي فيها، أقول العقل وليس النظريات.
الإيمان ليس هو صرخة فى الظلام، ليس صرخة لا ندرى إلى من نوجهها. إيمان قائد المئة ربما يكون غير واضح حسب الظاهر، لأن معرفته بيسوع تكاد تكون سطحية. ولكن إيمانه فى جوهره سليم ودقيق لأنه اشتمل على ممارسة واضحة وعملية: إيمان بأن يسوع لديه إمكانية شفاء غلامه. فالإيمان بالرب لا يعنى فقط انفتاح القلب، بل ممارسة لها ثمارها فى حياتنا وأعمالنا وفى قرارتنا. فأن أؤمن بيسوع فهذا أمر عظيم، ولكن لا بد أن استثمر هذا الإيمان فأطبقه فى مواقف واضحة وملموسة لأجل بنائي الروحي، هنا فقط يتحول الإيمان إلى حدث إيجابي وإلا أصبح إيماناً مبهاً.
الإيمان ليس حدث عاطفي قد يشمل الأحاسيس، بل قوة دافعة تُدخِل الإرادة تحت طاعة يسوع لأنه ليس هناك أعظم من دخول يسوع فى حياتنا وأعمالنا اليومية. ومن ناحية أخرى هناك اعتراف بقدرة الشخص الذى نؤمن به، فقائد المئة ينتظر من يسوع ما هو فوق طبيعة البشر، إذ ليس فى قدرة البشر أن يشفوا إنساناً بكلمة. يسوع شخص رائع حقاً، فريد فى عظمته، تكفى كلمة واحدة من فمه الطاهر أن تتمم الشفاء.
الآن نصل للعمود الثالث الذى يرتكز عليه الإيمان وهو الطاعة:
لنراجع قصة قائد المئة مرة أخرى ونحدد فكر قائد المئة فى عمله اليومي: إنه ضابط يأمر من هو تحت يده، وهو أيضاً ينفذ ما يصدر إليه من أوامر، لأجل ذلك فهو لا يرى ضرورة لمجئ الرب يسوع إلى بيته “لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي”، ولكن كلمة واحدة منك تكفي، ولأن الأمر صادر منك أنت، فسوف يتم كل شئ. لا داعى أن تأتي بنفسك- قل كلمتك وكفى.
هنا نجد أنفسنا أمام المعنى العبري لكلمة “إيمان”، وهى كلمة مشتقة من نفس أصل كلمة “آمين”، ما الذى تعنيه كلمة آمين؟ للأسف فإن هذه الكلمة فقدت معناها وحيويتها. صارت كليشيه معناه “ليكن هذا”، صارت كلمة مجردة لا معنى لها، ولا تدخلنا إلى الأعماق، وليست صلبة ثابتة كالصخرة، بعكس المعنى العبرانى الذى يعنى: هذا متفق عليه وثابت وليس محل نقاش. كلمة آمين = نعم، أو هو كذلك بالفعل ولا يمكن أن يكون أى شئ آخر. إذن كلمة “إيمان” تعنى طاعة لما هو غير قابل للنقاش، تنازل إرادي لما هو ثابت ومتفق عليه، لما هو غير قابل للتغيّر.
لنتأمل عن قرب ما الذى يعنيه إيمان الطاعة. سبق أن أشرت أن الإيمان ليس صرخة فى الظلام لسنا ندرى إلى من نوجهها. إنه قوة دافعة نحو شخص لن نعرفه المعرفة الكاملة ونحن على الأرض، ورغم ذلك نثق فيه، شخص يتعدانا ويفوقنا كما يتعدى اللانهائي النهاية نفسها ويفوقها.
والأن نصل إلى العمود الرابع للإيمان وهو: حضور الله:
ففي الإيمان يوجد حضور وعدم حضور: بمعنى انه عندما يكون هناك إيمان فهذا معناه أن هناك شئ ما ناقص من ناحية المعرفة.
وعلى كل فإن كل فعل إيمان يلقينا فى البحر الواسع، ولكن بثقة تامة من ناحيتنا، نثق أننا لن نغرق بل سوف نصل إلى الهدف والملجأ، السلام فى المخلص.
بين صفحات الإنجيل، نجد صيغ مختلفة حينما تكون هناك مواقف إيمان، فمثلاً عندما أقول: “أؤمن بالله”- فهذا معناه أن الله لا يخطئ وبالتالى فهو لن يخدعني، وعندما يتكلم أثق فى كلامه حتى لو تكلم عن الأمور التى لا أستطيع أن أتحقق منها. عبارة “أؤمن بالله” تعنى توجيه أشمل وأعَمّ: هو ارتباط كياننا- وإرادتنا- وفكرنا بالكلمة الأزلي، والإعلان الإلهي، ولا يوجد إيمان خارج ذلك الإرتباط.
وباختصار فإن ما نتعلمه من قصة قائد المئة هو: “فقط قل كلمة- لا أطالبك بالمجئ إلى بيتي – عندى ثقة تامة وكاملة بك. أثق أن كلمتك سوف تشفي غلامي .. فقط قل كلمتك هذه).
هذا هو الإيمان الصحيح: إذا استطعنا أن نجعل حياتنا متوقفة على كلمات المخلص، فإننا سوف نحيا الإيمان الأعمق. لو كانت لنا الثقة خلال حياة الإيمان الطويلة، بأن الحل إنما يأتى من هذه الكلمة البسيطة، لأصبح لدينا ذخيرة إيمانية كالتى يصفها يسوع: “بأنه لم يجد مثلها”. يسوع الذى تعجب من عدم إيمان أهل الناصرة يمر وسطنا اليوم وينظر إلى كل واحد منا بنظرة تغوص إلى أعماق كياننا. ما الذى يراه فينا .هل يرى إيمان مماثل لإيمان قائد المئة أم عدم إيمان مشابهاً لأهل الناصرة. ما الذي يا ترى يمكن يتعجب منه: من إيماننا أو من عدم إيماننا؟!.
المراجع
[1]– تفسير مرقس ص ٢٦١ – القمص تادرس يعقـوب ملطي.
[2]– تفسير إنجيل يوحنا (المجلد الثاني) – إصحاح ٨ – ترجمة دكتور نصحي عبد الشهيد.
[3]– تفسير إنجيل يوحنا – الإصحاح الثامن – القمص تادرس يعقوب ملطي.
[4]– كتاب من مجد الي مجد للقديس غريغوريوس النيسي – صفحة ٤٧ – تعريب القمص إشعياء ميخائيل – كنيسة الملاك بالظاهر.
[5] – اختبرني يا الله صفحة ٢٧٧ – قداسة البابا تواضروس الثاني
[6]– كتاب معالم الطريق إلي الله – صفحة ٥٢ – الأنبا يؤانس أسقف الغربية
[7]– الكتاب الشهري للشباب والخدام – ديسمبر 2009- صفحة 3 – بيت التكريس لخدمة الكرازة.