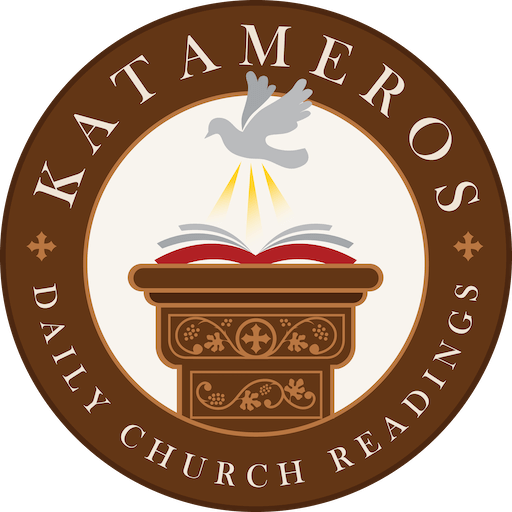كنيسة البهاء والمجد المُمتلئة من روح الله
تختم قراءات الخمسين يوم المقدسة بالإعلان عن بهاء الكنيسة وكمالها كتاج لكل المعاني والإعلانات الإلهية في القراءات خلال الخمسين يوم من القيامة حتى حلول الروح القدس..
فالكنيسة بهية وكاملة وممجدة لأنها: أيقونة الثالوث، وكل ما فيها جميل بحضور المسيح فيها وبر الآب عليها وملء الروح القدس في عبادتها وتعليمها ورعايتها.
المزامير
لذلك تعلن المزامير عن بهاء كنيسة العهد الجديد المطعمة من كل الأمم والقبائل والشعوب ومن كل لسان..
- فيعلن مزمور عشية عن ← دعوة الأمم في المسيح وتحريرهم من قبضة الشياطين ودخولهم الحظيرة على أساس قبول الله لهم وبره الإلهي.. “الذين أنقذهم من أيدي أعدائهم ومن البلدان جمعهم من المشارق والمغارب والشمال والبحر” (مز١٠٦: ٢، ٣).
- وفي مزمور باكر عن ← إستعلان مراحم الله الغنية في كل الأرض وتحول الشعوب من القساوة والشر إلى الرحمة والحق. “إمتلأت الأرض من رحمة الرب” (مز٣٢: ٥).
- وفي مزمور القداس عن ← نتيجة فيض مراحم الرب للأمم انطلاقهم وتطلعهم إلى تمجيد إسم الرب وهذا هو إحدى إعلانات كمالات الكنيسة، حياتها في تمجيد إسم الرب وتسبيحها الدائم له.. “فإعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم” (مز١٠٧: ٢).
إنجيل عشية
وفي إنجيل عشية عن ← كنيسة الأمم وكنيسة اليهود..
- كنيسة الأمم التي كانت تحيا في النجاسة والدنس وعبثاً حاولت أن تنال التطهير من العالم وحكمته وفلسفته، فجاءت من ورائه بإتضاع بعد أن تخلت عن كبريائها وذاتها لتلمس هدب ثوبه، لأنها لم تكن بعد تستطيع لمس جسده، فنالت التطهير والشفاء بعد نزيف الخطية أثنتي عشر سنة..
- ويعلن أيضاً عن كنيسة اليهود التي ظنت أنها تملك الحياة وحدها دون سائر الأمم، ولكن إكتشفت أنها بالشكل وحده تسرع إلى الموت وتحتاج أن يعيد إبن الله إليها روح الحياة مرة أخرى..
وإذا كانت كنيسة اليهود إحتاجت أن يأتي إليها إبن الله ويذهب إلى بيتها..
فإن كنيسة الأمم قابلته في الطريق واقتنصت الخلاص بإيمانها..
وبالرغم من دعوة رئيس المجمع للسيد فإن الأمم سبقوا اليهود من دون دعوة..
وأيضاً رغم وجود بيت لليهود وشكل ومجمع.. فإن الأمم في الطرق والشوارع وجدوا المسيا وتمسكوا حتى ولو بهدب ثوبه..
وانتهت الأثنى عشر سنة من النجاسة والدنس من الأمم..
وانتهت الأثنى عشر سنة من شكل الحياة دون جوهرها مع اليهود..
ونالا معاً قوة الحياة في المسيح وصارا كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.
انجيل باكر
وفي انجيل باكر عن ← كمال ومجد الثالوث للكنيسة في العهد الجديد خلال شركة الكنيسة مع الثالوث وخلال إعلان مجده فيها. “وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك الواحد وحده الإله الحق ويسوع المسيح الذي أرسلته….”.. “وكل ما لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا تمجدت فيهم”.
البولس
وفي البولس ← يظهر بهاء الكنيسة وكمالها ومجدها بمدى إعلانها عن المحبة الإلهية في سلوك أعضائها، فالمحبة هي عصب الكنيسة كما يقول المتنيح أبونا بيشوي كامل، وكلما كانت المحبة واضحة ومتجلية في الكنيسة كلما استعلن مجد الله فيها “وأيضاً أريكم سبيلاً آخر أفضل جداً… المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ… المحبة لا تسقط أبداً، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم سيبطل”..
كما أن دور المواهب في الكنيسة أن يبنيها، فالمواهب التي تعلن بهاء الكنيسة هي التي تقود إلى البنيان. “من يتكلم بلسان يبني نفسه وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة”.
الكاثوليكون
وفي الكاثوليكون فيعلن عن ← عطايا الثالوث للكنيسة في المسيح، وهنا يتكلَّم عن ثلاث عطايا، غفران الخطايا – ومعرفة الله – والنصرة علي الشرير “أكتب إليكم أيها البنون فإنه قد غُفِرَت لكم خطاياكم من أجل إسمه… لأنكم قد عرفتم الذي من البدء… لأنكم قد غلبتم الشرير… لأنكم قدعرفتم الآب… لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير”.
الابركسيس
ويظهر الابركسيس ← بهاء الكنيسة وكمالها رغم نقائص البشر، فالكنيسة لم تنقص بخروج أريوس ومقدونيوس ونسطور وأوطاخي منها، بل هي دائماً كاملة بمسيحها، وهم أغصان غريبة عاشت في الكنيسة بجسمها، ولكن كانت أعماقها وروحها غريبة عن روح الكنيسة وفكرها، فهم خرجوا منها لكنهم لم يكونوا منها، لأنهم لو كانوا منها لبقوا معها، ولكن ليظهر أنهم ليسوا جميعهم منها،
لذلك يوضح الأبركسيس ← خطية يهوذا وهلاكه، واختيار الكنيسة للقديس متياس كإعلان عن كمال الكنيسة رغم نقائص البشر. “فقال أيها الرجال أخوتنا كان ينبغي أن يكمل هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله على لسان داود عن يهوذا… إذ كان معدوداً بيننا وكان له نصيب في هذه الخدمة هذا الذي اقتنى له حقلاً من أجرة الظلم… وأسقفيته يأخذها غيره… فأقاموا اثنين يوسف.. ومتياس وصلوا.. ثم القوا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولاً.
إنجيل القداس
ثم يختم انجيل القداس ← بوحدة الكنيسة الكاملة التي على مثال الثالوث ومن خلال الثالوث فيها “ليكونوا جميعهم واحداً كما أنك أيها الآب فيَّ وأنا أيضاً فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا… وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضاً واحداً كما نحن أيضاً واحد وأنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا كاملين هم أيضاً في الوحدة”.
ملخص القراءات
- بهاء كنيسة العهد الجديد المُطعَّمة من كل القبائل والشعوب والألسنة. (مزمور عشية، وباكر، والقداس).
- تقابل إحتياج كنيسة الأمم في نزيف أوجاعها مع كنيسة اليهود في بطلان شكلها دون حياة مع لقاءهم بالرب وخلاصهم معاً من النزيف والموت. (انجيل عشية وباكر).
- المحبّة هي عصب الكنيسة وأيقونة الثالوث. (البولس)
- غفران الخطايا ومعرفة الآب والنصرة علي الشرير عطايا الثالوث للكنيسة. (الكاثوليكون).
- نقائص البشر وإنحراف الرعاة لا يُوقف عمل الروح في الكنيسة. (الإبركسيس).
- الكنيسة الكاملة هي التي تُعْلِن مجد الثالوث فيها وتقود أولادها للشركة معه. (انجيل القدَّاس).
عظات آبائية ليوم السبت من الأسبوع السابع من الخمسين يوم المقدسة
شرح لأنجيل القداس – القديس كيرلس الأسكندري[1]
(يو١٧: ١٤، ١٥) “أَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كَلاَمَكَ، وَالْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْعَالَمِ، كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ الْعَالَمِ، لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ الْعَالَمِ بَلْ أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ”.
هو يلفت نظرنا إلى النعمة التي من فوق من الآب، والتي يطلب زيادتها لنا، والتي يقول إن الآب يحب أن يعطيها لأولئك الذين يتعرضون للخطر من أجله، وذلك كمكافأة عادلة يستحقونها. فالعالم يبغض أولئك الذين يعبدون الله، والذين يطيعون وصاياه التي وضعها لهم، وهم الذين يستخفون باللذة العالمية، وهم أيضا الذين – سينالون معونة ونعمة منه، وسعادة دائمة. فبالتأكيد إن الذين يعتمدون عليه ويجاهدون بشجاعة من أجله، سوف ينالون مكافأة مناسبة للهدف الذي يسعون إليه لذلك، يقول المخلص: “أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم ابغضهم انهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم”، وكأنه يقول إنهم قبلوا بفرح كثير كلامك الذي أعطيته أنا لهم، أعني رسالة الإنجيل، التي تحرر الذين يقبلونها من الحياة العالمية والأفكار الأرضية، لذلك أيضا صاروا مكروهين من العالم، أي من أولئك الذين اختاروا أن ينشغلوا بأمور هذا العالم، والذين يحبون اللذة العالمية والحياة الدنسة جداً.
فإن حديث القديسين لا يسر محبي الدنيا، فحديثهم يستخف بصعوبات هذه الحياة، وينبه إلى أن الحياة العالمية مكروهة من الله، ويدينون شرها، ويوجهون لوماً شديداً لأولئك الذين يظنون أن السعادة تكون في الإستسلام للإغراء والارتباط المستمر بشر هذا العالم. وهم يدعون للإنتصار على كل الرغبات الأنانية، ويحتقرون الطموح، ويعلمون الناس أن ينفروا من الطمع الذي هو أصل كل الشرور، وأن يطرحوه بعيداً عنهم، كما أنهم يحثون الذين اصطادتهم شبكة إبليس، أن يهربوا من الخداعات القديمة، وأن يلجأوا إلى الله خالق الكل.
وهو يقول، أيها الآب، إنهم مكروهون لهذا السبب، فإن العالم لا يطيق رائحة تعليمهم، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة أو خطيئة ، بل لأني أعطيتهم كلامك، حتى أنهم ليسوا من العالم مثلما أني أنا لست من العالم. لأن الحياة التي تسلك بحسب المسيح، هي منفصلة تماماً عن الأفكار الأرضية والسيرة العالمية، هذه الحياة، عندما نسير فيها نحن أيضا، فإننا نحسب أننا لسنا من بين أناس هذا العالم لذلك فإن بطرس الرسول يحثنا أن “نتبع خطواته” (خطوات المسيح) انظر (1بط۲۱:۲)؛ ونحن سنتبع خطواته، حسناً، عندما نحب فقط الأمور التي ليست من هذا العالم، وإذ نرتفع بعقولنا فوق الأفكار الجسدية، فإننا نثبت نظرنا فقط على الأمور السمائية.
وهو أيضا يحسب نفسه مع تلاميذه بسبب ناسوته، وإذا تمثلنا به في حياته بيننا كإنسان، فإننا نبلغ إلى كل أنواع الفضيلة، كما سبق أن قلنا، ونعبر سالمين خلال كل شرور العالم، سالكين كغرباء ومبتعدين عن شره، وهذا ما يحثنا عليه بولس الإلهي مشيراً إلى نفسه وإلى المسيح وصليبه: ” الَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ الْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ” (غلا ٦: 14)، في موضع آخر يقول “كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي كَمَا أَنَا أَيْضًا بِالْمَسِيحِ” (١كو١:١١). بولس لم يتمثل بالمسيح من جهة كونه خالق العالم، لأن بولس لم ينشئ سماء جديدة، ولا أظهر لنا بحاراً جديدة أو أرضاً جديدة. فكيف تمثل بولس بالمسيح إذا؟. بالتأكيد إنه تمثل به بأن جعل أخلاقه وسلوكه صورة لحياة المسيح الذي هو الأصل لهذه الصورة، وذلك بقدر ما يستطيع بولس أن يبلغ إليه، لأنه لا يستطيع أحد أن يكون مساوياً للمسيح.
وإذ يضع الرب نفسه، على مستوانا، بسبب طبيعته البشرية، أو إذا تكلمنا بكلمات أكثر دقة، إذ يعطينا بركة إخراج أنفسنا من العالم بقوة الحياة التي تعلو الأمور العالمية لأن تعليم الإنجيل والحياة حسب الإنجيل هي فوق العالم. فإنه يقول إنه ليس من العالم وإننا نحن أيضا مثله لسنا من العالم، وإننا صرنا مثله، حيث إن كلمته الإلهية قد سكنت في قلوبنا. وإضافة إلى ذلك، هو يعلن أن العالم أبغضهم هم أيضاً كما أبغضه هو. العالم يبغض المسيح لأنه يتناقض مع كلماته ولا يقبل تعليمه، إذ أن أذهان البشر قد استسلمت للشهوات الدنيئة. وكما يبغض العالم مخلصنا المسيح، فإنه يبغض أيضاً أولئك الذين يحملون رسالته كما حملها بولس الرسول الذي قال “إِذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِنَا نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ اللهِ” (٢كو ٥: ٢٠).
ماذا يطلب إذاً، بعد أن أوضح أن التلاميذ مكروهون من أولئك المقيدين بشرور العالم؟ بقوله: “لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ الْعَالَمِ بَلْ أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ” (يو١٥:١٧). فالمسيح لا يريدهم أن يتركوا شئونهم البشرية، أو أن تخرج أرواحهم من أجسادهم، بينما لا يكونون قد أكملوا عملهم الرسولي، وصاروا متميزين بفضائل الحياة الإلهية، بل هو يريد لهم بعد أن يكونوا قد عاشوا حياتهم في صحبة الناس في العالم، وقد ارشدوا خطوات الذين هم خاصته إلى طريقة الحياة المرضية لله، عندئذ يؤخذون أخيراً محملين بالمجد الذي حققوه إلى المدينة السمائية وأن يسكنوا في صحبة الملائكة القديسين. كما نجد أحد القديسين يلجأ إلى الإله المحب للفضيلة صارخاً: “يَا إِلهِي، لاَ تَقْبِضْنِي فِي نِصْفِ أَيَّامِي” (مز٢٤:١٠٢)؛ لأن نفوس الأنقياء، لا يمكن -بدون غرض مفاجئ شديد- أن تخلع ثوب الجسد قبل أن يكونوا قد تكملوا في حياة القداسة أكثر من زملائهم من البشر، لذلك أيضاً فإن ناموس موسى يعلمنا أن الخطاة يفتقدون في الغضب بموت مبكِّر كعقاب ويكرر محذراً بالابتعاد عن الشر “لِمَاذَا تَمُوتُ فِي غَيْرِ وَقْتِكَ؟” (جا۱۷:۷).
إضافة إلى ذلك فلو أن القديسين ابتعدوا عن حياتنا اليومية، فهذا سينتج عنه ضرر قليل لغير الثابتين في الإيمان، فهؤلاء الضعفاء لن يجدوا إرشاداً في طريق البر بدون مساعدة أولئك الذين يستطيعون أن يرشدوهم في هذا الطريق، والرسول بولس كان عارفاً بهذا حينما قال “أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّا. وَلكِنْ أَنْ أَبْقَى فِي الْجَسَدِ أَلْزَمُ مِنْ أَجْلِكُمْ” (في١: ٢٣، ٢٤) لذلك فالمسيح، بسبب عنايته بخلاص الضعفاء، يقول إن أولئك الذين في العالم لا ينبغي أن يتركوا مهجورین بدون القديسين، الذين هم نور العالم، وهم ملح الأرض، ولكنه بالحري يسأل من أجل حفظ قديسيه لكي لا يمسهم الشرير بخبثه، إذ يجنبهم هجوم التجارب بقوة أبيه الكلي القدرة.
ينبغي أيضا أن نلاحظ أنه يدعو الكلمة التي هي كلمته والمعطاة منه، أعني الإنجيل، أنها كلمة الله الآب، مبيناً بذلك أنه غير منفصل عن الآب، بل هو مساوي له في الجوهر، ونجد في كتابات البشيرين أن شعب اليهود كانوا مندهشين منه “لأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ” (مت٢٩:٧). لأن الكتبة كانوا يطبقون تعليم الناموس في كل مرة في أحاديثهم معهم؛ أما ربنا يسوع المسيح فلم يكن يتبع الرموز التي في كتب الناموس كأنه مستعبد لها، بل إذ هو يجعل كلمته مميزة بالقوة الإلهية فإنه ينادي : ” قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَزْنِ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ:…” لا تشتهي (أنظر مت٢٧:٥، ۲۸). رغم أن الناموس يقول صراحة أنه لا ينبغي لأي واحد أن يضيف على قوانين الله أو ينقص منها. ولكن المسيح أنقص منها وأيًضا أضاف إليها، محولاً الرمز إلى الحقيقة. لذلك، فلا يمكن أن يحسب أنه من بين الذين هم تحت الناموس، أي من بين المخلوقات، لأن من وضعت على طبيعته وصية العبودية، يكون بالضرورة تحت الناموس، إذاً، فالمسيح يقول إن كلمته هي كلمة الآب، لأنه هو الكلمة الذي في الآب ويصدر منه، والذي يعلن مشيئة الألوهة، وأعني الألوهة الحقيقية الوحيدة التي في الآب والابن والروح القدس.
(يو۱۸:١٧، ۱۹) “كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى الْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى الْعَالَمِ، وَلأَجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ فِي الْحَقِّ”.
بعد أن أعطي الرب، اسم قدوس للآب خاصة، وبعد أن طلب أن يحفظ تلاميذه في الحق، أي في الروح
-[لأن “الروح هو الحق” كما يقول الرسول يوحنا انظر (يو١٦: ١٣)، كما أنه هو روح الحق أي روح الابن الوحيد نفسه انظر (يو١٣:١٦)]- فإنه يعلن أنه أرسلهم إلى العالم كما أرسله الآب إلى العالم، لأن يسوع هو رسول ورئيس كهنة إعترافنا كما يقول بولس الرسول انظر (عب۱:۳)، وذلك بحسب ناسوته وبواسطة نزوله بالتجسد. ثم يقول، إن التلاميذ بعد أن أتم إعدادهم، يحتاجون إلى التقديس من الآب القدوس، الذي يغرس فيهم الروح القدس بواسطة الابن. لأن تلاميذ المخلص لم يكن ممكناً بالمرة أن يصيروا لامعين جداً حتى يكونوا حملة المشاعل للعالم كله، وأن يصمدوا أمام وطأة تجارب أعدائهم، وأمام هجمات الشيطان المرعبة، لو لم تكن أذهانهم قد تقوت بواسطة الشركة مع الروح القدس؛ ولما تمكنوا باستمرار أن يحققوا أمراً لم يسمع به قبلاً، ويفوق كل قدرة بشرية، ولما إنقادوا بنور الروح القدس إلى معرفة كاملة للكتب الموحي بها، والتعاليم المقدسة التي للكنيسة.
وإضافة إلى ذلك، فإن المخلص “فيما هو مجتمع معهم” بعد قيامته من بين الأموات، كما هو مكتوب، وإذ أمرهم أن يكرزوا بالنعمة بواسطة الإيمان في كل العالم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعوه منه انظر (أع١: ٤)، ومن أفواه الأنبياء القديسين: لأنه “وَيَكُونُ بَعْدَ ذلِكَ أَنِّي أَسْكُبُ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ” انظر (يوئيل ٢٨:٢). والمخلص نفسه أعلن بوضوح أن روحه القدوس سيسكب عليهم، بقوله: “إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لأَقُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا الآنَ،
وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ” (يو١٦: ١٢، ۱۳)، وأيضا “وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَر”َ (يو١٤: ١٦). لأن الروح القدس هو خاص بالله الآب، كما أنه خاص بالابن نفسه، لا كأن الآب والابن هما كيانين منفصلين، ولا كأن الروح موجود في أي منهما منفصلاً عن الآخر، بل إذ أن الابن بالطبيعة صادر من الآب وكائن فيه (لكونه المولود الحقيقي لجوهره)، فالروح الذي هو خاص بالآب بالطبيعة، ينزل إلى البشر، مسكوباً من الآب ولكنه يصل إلى الخليقة بواسطة الابن نفسه؛ لا كأنه خادم أو عبد، بل هو ينبثق من جوهر الله الآب نفسه، ويسكب على أولئك الذين يستحقون أن ينالوه بواسطة الكلمة. والروح مساوٍ للابن في الجوهر. والروح منبثق (من الآب) كاقنوم متميز، وهو قائم فيه إلى الأبد وفي وحدة معه، وأيضا له أقنوم خاص به.
لأننا نعتقد أن الابن له وجوده الخاص كأقنوم وهو كائن في أبيه دائماً، وله في ذاته، الآب الذي ولده؛ وأن روح الآب هو بالحقيقة روح الابن، وأنه حينما يرسل الآب روحه إلى القديسين، فإن الابن أيضا يمنح الروح لهم لأنه روحه، بسبب وحدة جوهره مع الآب. وقد أوضح الابن نفسه أن الآب يعمل بواسطته في كل شيء، بقوله: “إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ” (يو٧:١٦). وأيضا: “وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ” (يو١٦:١٤). وواضح هنا أنه يعد بأن يرسل لنا المعزي.
وكأنه يقول: إذا حيث إن التلاميذ الذين يطيعون كلامي، قد أرسلوا إلى العالم كما أرسلت أنا، أحفظهم، أيها الآب القدوس في حقك، أي في كلمتك، الذي بواسطته يأتي الروح الذي يقدس. وما هو هدف المخلص من قوله هذا؟ إنه يسأل الآب أن يعطي لنا التقديس الذي في الروح وبواسطته، وهو يريد أن ذاك الذي كان فينا في العصر الأول للعالم، وفي بدء الخليقة (أي الروح)، أن يحييه الله في حياتنا من جديد. نقول هذا، لأن الابن الوحيد هو وسيطنا، ويقوم بدور شفيع لأجلنا أمام الآب في السماء ولكن لكي يكون شرحنا خاليا من كل غموض، ولكي يكون معنى ما قيل واضحا لسامعينا، فلنقل كلمات قليلة عن خلق الإنسان الأول.
قال موسى الموحى إليه، عن الإنسان الأول إن الله أخذ تراباً من الأرض وجبل منه الإنسان. ثم يخبرنا عن الطريقة التي بها أعطيت الحياة للجسد بعد تشكيله إذ يقول: “وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ” (تك٧:٢)؛ ومعنى ذلك أن الحياة أعطيت للإنسان مع التقديس بواسطة الروح، ولم تكن حياة الإنسان محرومة أو مقفرة من الطبيعة الإلهية، فإنه لا يمكن أن شيئاً له أصل وضيع، أن يخلق على صورة العلي، لو لم يكن قد أخذ ونال بواسطة الروح الذي يصوغه. كما لو كان قناعاً جميلاً بإرادة الله، لأنه كما أن روح الله هو الشبه الكامل لجوهر الابن الوحيد حسب قول الرسول بولس: “لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ” (رو۲۹:۸)، فهو (الروح) يجعل الذين يسكن فيهم مشابهين لصورة الآب، أي الابن. وهكذا تُرفع كل الأفكار إلى الآب بواسطة الابن، الذي يصدر من الآب ومعه الروح. لذلك، فهو يريد أن تُجدَّد طبيعة الإنسان وتُشكَّل من جديد لتكون على شكلها الأصلي بالشركة مع الروح القدس. لكي يلبسنا تلك النعمة الأولى، وإذ نتشكل من جديد لنكون مشابهين له، نستطيع أن نسود على الخطية التي تحكم في هذا العالم، ونلتصق بمحبة الله، ساعين بكل قوتنا نحو كل الأمور الصالحة، ورافعين أذهاننا فوق الشهوات الجسدية، ونحفظ جمال صورته المغروسة فينا غير مشوهة. فإن هذه هي الحياة الروحانية، وهذه هي العبادة بالروح ويمكن أن نلخص الأمر كله في أن المسيح أنعم علينا بالموهبة الإنسانية، أي التقديس بالروح والشركة مع الطبيعة الإلهية، وجعل تلاميذه هم أول من ينالونها لأنه صادق هو القول: “يَجِبُ أَنَّ الْحَرَّاثَ الَّذِي يَتْعَبُ، يَشْتَرِكُ هُوَ أَوَّلاً فِي الأَثْمَارِ” (٢تي٦:٢). ولكي يكون متقدماً في كل شيء انظر (كو1: ١٨)، هنا أيضاً لأنه يليق به أنه لكونه واحداً بين كثيرين، وهو إنسان مثلنا نحن البشر، ينبغي بمشابهته لنا أن يرى أنه بالحقيقية البدء، والباب والطريق لكل الصالحات لأجلنا، ولذلك أضاف هذه الكلمات “وَلأَجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي” (یو۱۹:۱۷).
هذا القول يصعب شرحه ويعسر فهمه. ومع ذلك فإن الكلمة الذي يجعل كل الأشياء واضحة وهو الذي “يَكْشِفُ الْعَمَائِقَ مِنَ الظَّلاَمِ” (أي٢٢:١٢)، سوف يعلن لنا أيضا هذا السر. فما يحضره أي إنسان كتقدمة مكرسة لله، يقال إنه يتقدس بحسب الناموس، كما في حالة كل بكر فاتح رحم بين بني إسرائيل، لأن الله قال لموسى القديس: “قَدِّسْ لِي كُلَّ بِكْرٍ، كُلَّ فَاتِحِ رَحِمٍ” (خر۲:۱۳)، أي أن يقدمه ويكرسه ويفرزه كمقدس، نحن لا نؤكد، ولا ننصت إلى أي واحد يقترح أن الله أمر موسى أن يعطي أي تقديس بالروح، لأن قامة الكائنات المخلوقة لا تبلغ إلى القدرة أن تعمل مثل هذا العمل، بل هذا العمل لائق بالله وحده ولا يمكن أن ينسب لغيره، وأيضاً حينما أراد الله أن يعين الشيوخ الذين يساعدون موسى، فهو لم يأمر موسى أن يعطي التقديس لأولئك الذين اختيروا، بل بدلاً من ذلك قال بوضوح، أنه سيأخذ من الروح الذي كان على موسى ويضع على كل واحد من الشيوخ الذين دعوا. لأن قوة التقديس بواسطة الشركة مع الروح القدس تخص فقط طبيعة ضابط الكون، وما هو معنى التقديس، أعني بحسب عادات الناموس، هذا ما يوضحه لنا سليمان بقوله: “هُوَ شَرَكٌ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَلْغُوَ قَائِلاً: «مُقَدَّسٌ»، وَبَعْدَ النَّذْرِ أَنْ يَسْأَلَ” (أم٢٥:٢٠).
إذاً، فحيث إن هذا هو التقديس، بحسب عادة التقديم والتخصيص فإننا نقول إن الابن قدس نفسه لأجلنا بهذا المعنى. لأنه بذل نفسه كتقدمة وذبيحة مقدسة لله الآب، “مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ” (٢كو ٥: ١٩)، وأتى بالجنس البشري الذي كان قد سقط، إلى القرابة مع الآب “لأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا” بحسب المكتوب (أف١٤:٢).
وفي الحقيقة لم تكن هناك طريقة لتحقيق مصالحتنا مع الله سوى بالمسيح الذي يخلصنا ويعطينا الشركة في الروح القدس والتقديس. لأن الذي يربطنا معاً ويوحدنا مع الله هو الروح القدس، الذي عندما نناله نصير شركاء الطبيعة الإلهية، ويدخل الآب نفسه إلى قلوبنا بواسطة الآب والابن، ويوحنا الحكيم أيضاً يكتب لنا عن الآب قائلاً: “بِهذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا نَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا: أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوحِهِ” (١يو١٣:٤). ويقول الرسول بولس أيضاً “ثُمَّ بِمَا أَنَّكُمْ أَبْنَاءٌ، أَرْسَلَ اللهُ رُوحَ ابْنِهِ إِلَى قُلُوبِكُمْ صَارِخًا: يَا أَبَا الآبُ” (غلا٦:٤). فإنه لو كنا ظللنا بدون الاشتراك في الروح القدس لما كنا قد عرفنا أن الله كائن فينا، ولو لم نكن قد إغتنينا بالروح القدس، الذي يجعلنا في رتبة البنين، لما كنا قد صرنا أبناء لله بالمرة. فكيف كان يمكن أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية، دون أن يكون الله فينا، وكيف كان يمكن أن نكون متحدين به بدون الشركة مع الروح القدس؟
ولكن الآن، نحن شركاء في الطبيعة التي تعلو على الكون وقد صرنا هياكل لله، لأن الابن الوحيد قدس ذاته لأجل (محىو) خطايانا، أي أنه قدم نفسه وصار ذبيحة مقدسة رائحة طيبة لله الآب انظر (أف ٢:٥) فهو بينما هو إله قد جاء (بالجسد) وبني جداراً فاصلاً بين الطبيعة البشرية والخطية. وهكذا فلا يوجد أي شيء يمكن أن يعوقنا عن أن ندخل إلى الله، وأن يكون لنا شركة صحيحة معه من خلال الشركة مع الروح القدس، الذي يشكلنا من جديد على البر والقداسة والمثال الأصلي للإنسان.
لأنه إن كانت الخطية تفصل الإنسان وتبعده عن الله، فإن البر يكون رباط إتحاد ويضعنا إلى جانب الله دون أن يفصلنا شيء عنه. لقد تبررنا بالإيمان بالمسيح. الذي “الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا” كما يقول الكتاب انظر (رو٤: ٢٥).
لأنه فيه كباكورة لجنسنا، أعيد تشكيل طبيعة الإنسان تماماً إلى جدة الحياة وإذ ارتفعت طبيعتنا إلى بدايتها الأولى، فإنها تشكلت من جديد للتقديس، يقول “أَيُّهَا الآبُ قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ”، وذلك لأن “كَلاَمُكَ هُوَ حَق” (يو۱۷:۱۷)، أي كلمتك هو أنا. لأني قدست نفسي لأجلهم، أي أتيت بنفسي كتقدمة، واحد يموت لأجل كثيرين، لكي أصلحهم إلى جدة الحياة، ولكي يكونوا مقدسين في الحق، أي فيَّ.
والآن، إذ قد شرحنا الحديث السابق، وصار مفهوماً بالمعنى الذي قد أعطيناه الآن، فإننا لن نتأخر عن الدخول في بحث آخر. لأنه أن نكون غيورين جداً في البحث عن معنى المقاطع الصعبة في الكتاب، ينبغي كما أعتقد أن تعطى كرامة كبيرة لمن عندهم هذه الغيرة، وأيضاً للذين يصغون إليهم بإنتباه، قال ربنا يسوع المسيح إنه قدس نفسه لأجلنا لكي نكون نحن أيضا “مُقَدَّسِينَ فِي الْحَقِّ”، بأي معنى تقدس هو، وهو بالطبيعة قدوس لكي نتقدس نحن أيضاً، دعنا إذا نبحث هذا الأمر، ونحن ملتزمون بتعاليم الكنيسة، وغير مبتعدين عن قاعدة الإيمان المستقيمة.
إذاً، تقول إن الابن الوحيد، إذ هو بالطبيعة الله وفي صورة الله الآب، ومساوٍ له، قد “أَخْلَى نَفْسَهُ” بحسب الكتاب، وصار إنساناً مولوداً من إمرأة، أخذاً كل صفات طبيعة الإنسان، ما عدا الخطية، وبطريقة لا يمكن النطق بها. وحد نفسه بطبيعتنا بإرادته الحرة، لكي يجدد طبيعتنا. في نفسه أولاً، وبواسطة نفسه. إلى ذلك المجد الذي كان لها في البداية؛ وإذ أثبت أنه آدم الثاني، أي الإنسان السمائي، ولكونه المتقدم، وباكورة أولئك الذين يتم بناءهم إلى جدة الحياة، أي في عدم الفساد وفي البر والقداسة، التي بواسطة الروح القدس، فإنه من خلال نفسه يرسل العطايا الصالحة لكل جنس البشر. لهذا السبب، فرغم أنه هو الحياة بالطبيعة، صار كميت، حتى أنه إذ قد أباد قوة الموت فينا، يشكلنا من جديد بحسب حياته هو، وإذ هو نفسه بر الله الآب، صار خطية لأجلنا لأنه حسب قول النبي “يحمل هو نفسه خطايانا ” (إش٤:٥٣)، “وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ” (إش١٢:٥٣)، لكي يبررنا بواسطة نفسه، “إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا.. مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِالصَّلِيبِ” بحسب الكتاب (كو١٤:٢).
ولكونه هو نفسه أيضا بالطبيعة قدوس كإله، وهو يمنح الخليقة كلها شركة في الروح القدس من أجل استمرارهم وثباتهم وتقديسهم، فإنه يتقدس لحسابنا في الروح القدس، وليس أحد غيره هو الذي يقدسه، بل بالحري هو نفسه يعمل بنفسه لتقديس جسده الخاص. فهو يأخذ روحه الخاص ويشترك فيه بصفته إنساناً، وهو كإله يعطي الروح لذاته، وهو قد فعل هذا لأجلنا وليس لأجل ذاته، لكي إذ تبدأ نعمة التقديس منه هو أولاً، فإنها تصل حتى إلى كل جنس البشر.
وكما أنه بتعدي آدم وعصيانه، وهو أول جنسنا، حكم على الطبيعة البشرية بالموت، بخطية إنسان واحد، إذ سمع الإنسان الأول الحكم القائل: “لأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ” (تك٣: ١٩)، أعتقد أنه بنفس الطريقة – بطاعة وبر المسيح، عندما صار تحت الناموس، رغم أنه كإله هو معطي الناموس. هكذا تمتد الإفخارستيا والقوة المحيية للروح القدس إلى كل البشر.
لأن الروح يعيد إلى عدم الفساد ما كان قد فسد بالخطية، ويشكل إلى جدة الحياة ما كان عتيقاً، وقريباً من الاضمحلال.
ولكن ربما تسألون، إذاً، كيف يتقدس ذاك الذي هو بالطبيعة قدوس، وينال التقديس من خارجه؟ وبأي معنى يكون ذاك الذي يمنح الروح لكل من يستحقونه.
وأعني الذين في السماء والذين على الأرض. أقول كيف يمنح لذاته هذا الروح مثل هذه الأمور يصعب فحصها، أو فهمها، ويصعب شرحها، عندما تظن أن الكلمة الذي صدر من الآب كأنه خال من الروح، أو أن له الروح جزئيا فقط ولكن حينما تفكرفي التجسد الذي يفوق الإدراك واتحاد الكلمة بالجسد وتضع أمام ذهنك أن الإله الحقيقي قد صار إنساناً مثلنا، فإنك لا تعود تندهش بعد ذلك، وتطرح عنك ارتباك الذهن، وتضع أمام أفكارك، الابن الذي هو إله وإنسان معاً في نفس الوقت، فإنك لن تفكر أن الصفات الخاصة بالبشرية ينبغي أن تطرح جانباً، وهي قد صارت لأقنوم ذاك الذي هو الابن بالطبيعة، أعني المسيح فمثلاً ألا نفكر نحن أن الموت غريب عن طبيعة الكلمة الواهب الحياة للجميع؟
ولكنك ستقول، إنه إحتمل الموت في الجسد، لأن الجسد مائت، ولذلك يقال إنه يموت، لأن جسده الخاص قد مات.
فكرتك هذه صائبة تماماً، وأنت تتكلم حسناً، فهو في خطته لأجل فدائنا قدم جسده للموت، ولم يمنع بقوته الإلهية، رباطات الموت من أن تقيده. لأنه جاء بيننا وصار إنساناً، لا لأجل نفسه، بل بالحري، هو أعد الطريق بواسطة نفسه وفي نفسه للطبيعة البشرية لكي تفلت من الموت، وترجع إلى عدم فسادها الأصلي. دعنا إذاً بطريقة تفكير مماثلة، نفسر طريقة تقديسه هو. هل يمكننا أن نؤكد أن الجسد الذي من الأرض هو مقدس بحسب طبيعته، حتى لو لم يأخذ التقديس من الله، الذي هو قدوس بالطبيعة؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ لأنه أي اختلاف عندئذ يمكن أن يكون بين الجسد الأرضي، وذلك الجوهر القدوس والنقي؟ وإن كان صحيحاً أن يقال إن كل المخلوقات العاقلة، بل وكل المخلوقات عموماً، لا تتمنع بالتقديس كثمرة طبيعتها الخاصة، بل هي تستعير النعمة من ذاك الذي هو بالطبيعة قدوس، ألا يكون قمة السخف أن نظن أن الجسد ليس في حاجة إلى الله، الذي يستطيع أن يقدس كل الأشياء؟ إذاً، فحيث إن الجسد ليس مقدساً من ذاته، لذلك فهو قد نال التقديس حتى في حالة المسيح الكلمة الذي سكن في الجسد، مقدساً هيكله بواسطة الروح القدس، وجاعلاً إياه أداة حية لطبيعته الإلهية. لهذا السبب، فإن جسد المسيح قدوس وطاهر، لكونه بحسب ما قلت حالاً-كما يقول بولس الرسول انظر (كو٩:٢). هيكل الكلمة المتحد به.
لذلك، نزل عليه الروح القدس – على شكل حمامة من السماء، ولقد شهد يوحنا الحكيم بهذا، لكي تعرف أن الروح نزل على المسيح أولاً كباكورة للطبيعة البشرية التي تجددت، نزل عليه كإنسان، وبهذه الصفة الإنسانية يمكن أن يتقدس. ونحن لا نقول إن المسيح صار مقدساً حينما رأى المعمدان “الروح نازلاً عليه” انظر (يو۳۲:۱)، لأنه قدوس وهو لا يزال في الرحم قبل أن يولد، فقد قال الملاك للعذراء المباركة “اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ” (لو٣٥:١). ومع ذلك فنحن نعتقد أن جسد المسيح تقدس بواسطة الروح. فالكلمة الذي هو قدوس بالطبيعة والمولود من الآب يمسح هيكله الخاص المتحد به مثلما يمسح أجساد الآخرين المخلوقين. والمرنم إذ عرف هذا صرخ وهو ينظر إلى شخص الابن الوحيد في الجسد قائلاً: “مِنْ أَجْلِ ذلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلهُكَ بِدُهْنِ الابْتِهَاجِ أَكْثَرَ مِنْ رُفَقَائِكَ” (مزه٧:٤). لأنه حينما يمسح الابن هيكل جسده، يقال إن الآب هو الذي يمسح. لأن الآب يعمل بواسطة الابن. لأن كل ما يعمله الابن ينسب إلى الآب الذي منه يصدر الابن، إذ أن الآب هو الجذر والينبوع لوليده.
لذلك لا نتعجب عندما يعلن الرب إنه يقدس ذاته، رغم أنه هو بالطبيعة قدوس، ولا تتعجب عندما يدعى الله أباه، في الكتاب، رغم انه هو نفسه بالطبيعة إله. ولكني أرى أننا يمكن بصواب أن نستعمل مثل هذه التعبيرات دون خوف من الخطأ، بسبب احتياج العقل البشري، وذلك عن طريق التشبيه بالعلاقات البشرية. إذاً فكما مات بالجسد لأجلنا كإنسان، رغم كونه إله بالطبيعة، وكما جعل نفسه بين المخلوقات بسبب إنسانيته، وهو يدعو الله أباه، وهو رب الكل، هكذا هو يؤكد أنه يقدس نفسه لأجلنا: لكي حينما يصل تأثير تقديسه لذاته إلينا نحن، على أساس أنه هو باكورة الطبيعة البشرية الجديدة. فنحن أيضاً يمكن أن نتقدس في الحق، أي في الروح القدس. لأن “الروح هو الحق” كما يقول يوحنا الرسول انظر (١يو٧:٤). لأن الروح غير منفصل عن الابن في الجوهر بأي حال، إذ أن الروح كائن في الابن وينبثق بواسطته.
هو يقول إنه أرسل إلى العالم، رغم أنه موجود في العالم قبل تجسده لأنه كان في العالم والعالم لم يعرفه بحسب الكتاب انظر (يو ١ :۱۰)، وهو يقصد أن الكيفية التي تم بها إرساله إلى العالم كانت بواسطة مسحة الروح القدس لكونه إنساناً، وهو “ملاك المشورة العظمى” حسب تشبيه النبي انظر (اش٦:٩) سبعينية. وحينما يقول إن تلاميذه أرسلوا منه ليعلنوا للعالم رسالة الإنجيل من السماء، فهو يوضح أنهم في إحتياج عظيم أن يتقدسوا في الحق، لكي يمكنهم أن يتمموا خدمة رسوليتهم إلى النهاية، بكل نجاح ونشاط.
شرح لأنجيل القداس – القديس أغسطينوس[2]
هذه الكراهية (من العالم) لم تكن بعد قد لحقت بهم في حياتهم، لكنها تحققت فيما بعد.
إنه يتحدث كعادته عن المستقبل في صيغة الماضي. وقد ألحق ذلك بسبب بغض العالم لهم قائلًا: “لأنهم ليسوا من العالم، كما أني لست من العالم“. هذا قد مُنح لهم خلال ميلادهم الجديد، لأنهم حسب ميلادهم كانوا من العالم، كما سبق فقال لهم: “أنا اخترتكم من العالم” (يو ١٥: ١٦). إنه امتياز لطيف وُهب لهم أن يصيروا مثله إذ هو “ليس من العالم” وذلك خلال الخلاص من العالم الذي قدمه لهم. على أي الأحوال لم يكن هو قط من العالم، فإنه حتى بالنسبة لأخذه شكل العبد وُلد من الروح القدس الذي وُلدوا هم منه ثانية. فإن كانوا هم بسبب هذا لم يعودوا بعد من العالم لولادتهم الثانية من الروح القدس، فبنفس السبب لم يكن هو قط من العالم لميلاده (تجسده) من الروح القدس.
من المهم وجودهم في العالم، وإن كانوا لم يعودوا بعد ينتسبون إليه.
ربما يُسأل: إن كانوا لم يعودوا بعد من العالم، سواء وهم لم يتقدسوا بعد في الحق أو تقدسوا فعلًا، فكيف يطلب هكذا (ألاَّ يأخذهم من العالم)؟ أليس هذا لأن حتى هؤلاء الذين تقدسوا يلزم أن يستمروا لأجل نموهم في التقديس، أو في القداسة؛ وهذا لا يتم بغير نعمة الله، بتقديس نموهم كما قدسهم في البداية؟ من هنا يقول بولس عن نفس الأمر: “الذي ابتدأ فيكم عملًا صالحًا يكمل إلى يوم يسوع المسيح” (في ١ : ٦).
ماذا يعني بكلماته: “قدّسهم في حقك” سوى “قدّسهم فيَّ”… فالآب يقدس في الحق، أي في كلمته، في ابنه الوحيد، يقدس ورثته والوارثون مع الابن.
رسل الآب ابنه ليس في الجسد الخاطئ، بل في شبه الجسد الخاطئ (رو ٨: ٣). وأرسل ابنه أولئك الذين وُلدوا في الجسد الخاطئ وقد تقدسوا به من دنس الخطية.
ماذا عني بكلماته: “ولأجلهم أنا أقدس ذاتي” إلاَّ إني أقدسهم فيّ، إذ هم (جزء) مني؟ فإن هؤلاء الذين يتحدث عنهم، كما قلت هم أعضاؤه؛ والرأس مع الأعضاء هم المسيح. وذلك كما يعلم الرسول عند حديثه عن ذرية إبراهيم: “فإن كنتم للمسيح فأنتم إذًا نسل إبراهيم”، وذلك بعد قوله: “لا يقول وفي الأنسال فإن كان نسل إبراهيم هو المسيح” (غل ٣: ١٦- ١٩)، فماذا يُعلن للذين يقول لهم: “أنتم إذًا نسل إبراهيم” سوى أنتم المسيح؟ وبنفس السمة يقول الرسول نفسه في موضع آخر: “الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي” (1كو١: ٢٤). لم يقل شدائدي بل “شدائد المسيح”، لأنه كان عضوًا في المسيح، وفي اضطهاداته إذ تعَّين للمسيح أن يحتملها في كل جسده، كان يملأ نصيبه من الشدائد. ولكي تتأكد من هذا في العبارة الماثلة أمامنا لاحظ ما يلي بعد ذلك… “ليكونوا هم أيضًا مقدسين في الحق“. وماذا يعني هذا سوى “فيّ”، وذلك حسب الحقيقة أن الحق هو الكلمة التي في البدء، والتي هي الله؟.
إذ كرز الرسل بكلمة الإيمان هذه بصورة رئيسية وفي البداية، هؤلاء الذين التصقوا به لذلك دُعيت “كلامهم“. على أي الأحوال، ليس بسبب هذا توقفت عن أن تكون “كلمة الله” لأنها دعيت “كلمتهم”، إذ يقول الرسول أن أهل تسالونيكي قبلوا منه “ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله” (١تس ٢: ١٣). “كلمة الله” لأنها أُعطيت بواسطة الله مجانًا. لكنها دعيت “كلمتهم” لأنها عُهدت إليهم بصفة رئيسية وفي البداية لكي يُكرز بها.
إنهم (الثالوث) فينا ونحن فيهم، بكونهم هم واحد في طبيعتهم، ونحن واحد في طبيعتنا. إنهم فينا بكونهم الله في هيكله، ونحن فيهم كخليقة في الخالق.
“ليكونوا هم أيضًا واحدًا فينا”. أضاف “فينا” لكي نعرف أن صيرورتنا واحدًا في الحب الذي بالإيمان غير المتغير يُنسب لنعمة الله وليس لأنفسنا، ولكن إذ يقول الرسول: “أنتم الذين كنتم قبلًا في ظلمة الآن نور”، فلكي لا ينسب أحد هذا الفعل لنفسه يقول: “في الرب” (أف ٥ : ٨)
ماذا كان هذا المجد إلا الخلود الذي تتقبله الطبيعة البشرية فيه؟
فإنه لم يتقبله هو وحده، ولكن كطريقته المعتادة بتدبيره المسبق الثابت يشير إلى المستقبل في صيغة الماضي، فإنه إذ هو الآن في موضع مجده، أي قيامته بالآب، يقيمنا هو نفسه إلى ذات المجد في النهاية.
ما يقوله هنا مشابه لقوله في موضع آخر: “كما أن الآب يقيم من الأموات ويحييهم، هكذا الابن يحيي من يشاء”…
“ما يفعله الآب” ليس بطريقة ما بينما “ما يفعله الابن” بطريقة أخرى، بل “بنفس الطريقة” راجع (يو٥: ١٩، ٢١). بهذا قام المسيح بذاته. لهذا قال: “انقضوا هذا الهيكل، وفي ثلاثة أيام أقيمه” (يو٢: ١٩). بهذا فإن مجد الخلود الذي قال إنه أخذه من الآب يُفهم أنه قد وهبه هو أيضًا لنفسه، وإن لم يكن قد قال هذا.
“أنا فيهم، وأنت فيّ” ، بمعنى إني في أولئك الذين أرسلتني إليهم، وأنت فيَّ أنا المُصالح العالم معك خلالي.
الآب يحبنا في الابن، لأن فيه اختارنا قبل تأسيس العالم (أف ١: ٤). لأن من يحب الابن الوحيد بالتأكيد يحب أعضاءه خلال عمله، إنه طعَّمنا فيه بالتبني، لكننا لسنا بهذا معادلين الابن الوحيد الذي به خُلقنا وأُعيدت خلقتنا، إذ يُقال: “لقد أحببتهم كما أحببتني“. فإن الشخص لا يكون دائمًا مساويًا للآخر حين يُقال: “كما هذا هكذا الآخر”…
إنه يحب الابن من جهة لاهوته، إذ ولده مساويًا لنفسه. يحبه أيضًا بكونه جسدًا لأن الابن الوحيد صار إنسانًا، وبكونه الكلمة فإن جسد الكلمة هو عزيز عليه. أما بالنسبة لنا فبكوننا أعضاء في ذاك الذي يحبه، ولكي ما نصير هكذا. لقد أحبنا لهذا السبب قبل أن يخلقنا.
بلا شك لا يكفي أن يقول: “أريد أن هؤلاء يكونون حيث أكون أنا” ، بل أضاف “معي“. فإن الوجود معه هو أعظم بركة… إننا لا نستطيع أن نشك أن المؤمن الحقيقي هو مع المسيح بالإيمان، ففي هذا يقول: “من ليس معي فهو علي” (مت١٢: ٣٠). ولكن حين قال: “أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا” تكلم على وجه التحديد عن تلك الرؤية التي بها نراه كما هو (١يو٣: ٢).
عظات آباء وخدّام معاصرين ليوم السبت من الأسبوع السابع من الخمسين يوم المقدسة
كنيستى جسد المسيح – للمتنيح القمص يوسف أسعد[3]
١- ربنا يسوع هو رأس الكنيسة (أف ٥: ٢٣) هو رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هى جسده (أف۱: ۲۲، ۲۴). لقد أكمل كل شيء وصعد بجسد حقيقي لكنه ممجد يحتفظ بسمات الآلام في يديه ورجليه وجنبه راجع (لو٢٤: ٣٩- 34)، (يو۲۰: ٢۰، ٢٧) لقد صار رأسنا الآن ممجداً.
لكنه رأس مرتبط بالجسد، لذلك فآثار المسامير وإكليل الشرك لا تزال إلى يومنا هذا يحمله جسده على الأرض أي كنيسته.. التي تعتبر القربانة المستديرة عن إتساعها في كل الأرض، والخمس الخروم المحيطة بصليب السيد الأوسط تعبر عن دوام حملها لآلام المسيح في أتعاب وأثقال لا تنتهي يحملها رأس المسيح المنظور على الأرض أى قداسة البابا والأب الأسقف والأب الكاهن. فالبابا رأس الكنيسة المجاهدة كلها، والأسقف رأس الإيبارشية، والكاهن رأس للموضع الذي يحمل نير رعايته.. ولهذا فإن الذي لا يجمع مع المسيح فهو يفرق، والذي لا يعمل مع باباه وأسقفه وكاهنه لا يعمل مع المسيح. ها بولس العظيم يعبر عن آلامه كرأس فيقول: “الَّذِي الآنَ أَفْرَحُ فِي آلاَمِي لأَجْلِكُمْ، وَأُكَمِّلُ نَقَائِصَ شَدَائِدِ الْمَسِيحِ فِي جِسْمِي لأَجْلِ جَسَدِهِ، الَّذِي هُوَ الْكَنِيسَةُ، الَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا، حَسَبَ تَدْبِيرِ اللهِ الْمُعْطَى لِي لأَجْلِكُمْ، لِتَتْمِيمِ كَلِمَةِ الله” (١کو١: ٢٤، ٢٥). هكذا يا عزيزي رأس الجسد دائما كثيرة الأوجاع.
٢- کنیستی لها رأس واحد، وأعضاء كثيرة.. فيها العين، وفيها اليد، وفيها الرجل، وفيها القدم.. لكل عضو فيها عمل هام ولكنه محدد عظيم لكنه مخصص. فمثلاً البصيرة للعين أي الشمامسة الممتلئين من الروح والحكمة الذين يكونوا عيناً واذناً للأسقف والكاهن.. وهكذا نجد هناك رسلاً، وأنبياء، ومعلمين، وقوات.. راجع (١کو۱۲: ۲۸، ۲۹).
وهكذا قالت الدسقولية، ليكن الأسقف كراع، والكاهن كمعلم، والشماس كخادم.. أي أن كنيسة المسيح وجسده تقوم على مبدأ هام وهو التخصص في العمل.. والتخصص لا يعني الإستقلالية والتقوقع، إنما التخصص المترابط الذي يعمل بروح الفريق الذي يعمل لحساب الكل لا لحساب الفرد. وستظل الكنيسة في نهضتها محتاجة لتخصص أعضاء مترابطين بالمحبة والكرامة والتقدير كل للآخر.
لعلك تفهم قصدي يا عزيزي إبن المسيح وعضو الكنيسة.. لكي أوضح أكثر: ليكن النجار في النجارة، والسباك في السباكة، والمدرس في دروس التقوية، والمقتدر في العطاء السخي بالمال والإمكانيات، والذي ليس له بجهده وعرقه، ليكن كل عضو في تخصص عمله ومواهبه عاملاً في كنيسة المسيح عملاً خاضعاً لروح الجماعة ورأسها بالحب والإحترام. هذا التنوع، والتخصص، والترابط بالحب، هو الذي يجعل جسد المسيح رغم جراحه وأشواكه في كل جيل ملآناً بصوت الطرب والفرح، والتعزية لا ينقطع من أفواه أعضائه جميعهم.
وهذا التنوع، والتخصص، والترابط بالحب يستنكر كل أسلوب يسيئ به عضو إلى آخر، وجماعة إلى أخرى، وهيئة لأخرى، وكنيسة لأخرى، ودير لآخر. نعم يستنكر هذا بشدة.. لأن حزن المسيح لا ينقطع بسبب قيام الأعضاء بعضهم على بعض تارة بالإدانة وتارة بالتشهير وتارة بالتعويق وتارة بعدم التقدير والاستخفاف بالجهد والتعب..
- يا يسوع: أعط الكنيسة أن تعاون كل عضو کي يتخصص فى موهبته لكي لا تهدر جهود في التكرار أو في التشتت، ولكي بهذا التنوع المتعمق يبرز جمال عروسك أمي وتزداد فعاليتها في خدمة النفوس وللشهادة للعالم باسمك العظيم المبارك..
وسامحني يا يسوع وسامح كل عضو يسيء إلى الآخر، ويهين عمله، ويشهر اسلوبه.. سامحني يا رب، وسامح الكل.
المراجع
[1] تفسير انجيل يوحنا للقديس كيرلس الاسكندري – المجلد الثاني صفحة ٣٨١ – ترجمة دكتور نصحي عبد الشهيد وآخرون.
[2] تفسير إنجيل يوحنا – الإصحاح السابع عشر – القمص تادرس يعقوب ملطي.
[3] كتاب كنيستي – القس يوسف أسعد.